إن الإسلام السياسي لم يمت. وهؤلاء الذين خرجوا علينا يعلنون موته وبدء حقبة ما بعد الإسلاميين مخطئون، وقد أثبتت الأحداث في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا هذا على نحو واضح. إن تيار الإسلام السياسي لا يوشك أن يختفي من المشهد أو حتى يغير من إيديولوجيته كما يظن البعض. وفي تصوري – وموقفي الإيديولوجي – وهو ما آمله أنه بات من الضروري أن لا نقف عند تيار الإسلام السياسي نفسه بل نتخطاه لنقدم تقييما نقديا للتيار الإسلامي بكل صوره وأشكاله. وقبل أن أوضّح السر في تبني هذا الموقف، لا بد أن ألفت الأنظار أولاً إلى نقاط ثلاث. فقد عمّت الحيرة وزادت حالة الالتباس، وروّج البعض الحجج المغرضة التي عادة ما تكون غريبة مضحكة، لذا صار واجبا علينا أن نسعى لتوضيح الأمور.
أولاً : إن الإخوان المسلمين في مصر أو حركة النهضة في تونس يحظون بشرعية شعبية وانتخابية في بلادهم، وعلى كل أنصار الديموقراطية أن يحترموا نتيجة صناديق الاقتراع. قد يختلف المرء مع قرارات أو مواقف الإسلاميين في السلطة لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نبرر انقلاباً عسكرياً في مصر – بمعنى أن المظاهرات السلمية التي تطالب العسكر بالانسحاب من المشهد معها كل الحق في رفض ألاعيب الجنرالات. وإذا كنا نتساءل عن مصير الديموقراطية في ظل وجود الإسلاميين في السلطة – مع افتراض إمكانية احترام القواعد الديموقراطية – فمن باب أولى أن نسأل أنفسنا هل سيكون هناك أي مظهر للديموقراطية في ظل مؤسسة عسكرية لم تحترم تلك القواعد ولو لمرة واحدة طوال ستين عاماً أو يزيد. وإذا نظرنا إلى تونس، في ظل زعزعة الاستقرار الداخلي، سواء عبر المناورات الضارة من جانب الإسلاميين من ذوي القناعات الحرفية المتشددة أو من جانب نظرائهم العلمانيين المتعصبين، ندرك جيدا أنه لا ينبغي أبداً أن يُسمح لعدم الاستقرار أن يقوض شرعية مؤسسات الدولة. فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن نبرر الخطأ متذرعين بالخلافات الإيديولوجية مع ممثلي الشعب المنتخبين.
ثانياً : قضية الاصطلاحات. لا شك أن هناك حالة من فوضى المصطلحات، فلا أحد يعرف على وجه التحديد من المقصود بالإسلاميين أو المقصود بالإسلام السياسي. هذا المصطلح الذي بات ازدرائيا إلى حد كبير ينسحب على العديد من الحركات بداية من القاعدة (ذات الانتشار العالمي الذي وصل مؤخرا إلى شمالي مالي) وحتى رموز حركة النهضة والإخوان المسلمين مرورا بأحزاب العدالة والتنمية في تركيا والمغرب (مع بعض التحفظات) ووصولاً إلى النظام الإيراني. وقد يكون من السذاجة أن نظن أن استمرار حالة فوضى المصطلح هذه،واستغلالها هو من قبيل الصدفة البحتة. بينما لا نجد من يطلق المصطلح ذاته على الملكيات والإمارات النفطية الخليجية، الحلفاء الأثرياء للغرب، الذين تؤكد أنظمتهم الحاكمة على أن الديموقراطية ليست من الإسلام في شيء؛ فهذه الأنظمة التي تطبق الشريعة في صورتها الحرفية القمعية، وتحرم النساء من المشاركة السياسية والاجتماعية، لا يُطلق عليها مصطلح « إسلامية » رغم أنها تستمد سياساتها وممارساتها من جوهر الإسلام السياسي.
لا بد لنا إذن أن نصف المنظمات أو الأحزاب الإسلامية المختلفة وصفاً حقيقيا : إذ منها ما هو سلمي، إصلاحي يلتزم بالمبادئ الشرعية، ومنها ما هو حرفي دوجمائي، وبعضها متطرف يتبنى العنف منهجا. بدون إدراك هذه الحقيقة، لن يتسنى لنا أن نخرج بتحليل علمي أو سياسي جاد. وإذا كان التركيز في هذه المقالة ينصب على التيار السلمي الإصلاحي، فلا مانع أن نتطرق إلى كل التيارات الإسلامية (استناداً إلى الفرضية التي ترى أن أنصار الإسلام السياسي يسعون إلى سلطة الدولة).
أخيراً : لا بد أن يكون واضحاً تمام الوضوح أن انتقادي لتيار الإسلام السياسي ليس معناه أبداً انحيازي إلى مواقف خصومه وبرامجهم السياسية ولا القبول بها. فعلى مدار أكثر من ستين عاما، أخفقت القوى التي تطلق على نفسها اسم الليبرالية أو التقدمية أو العلمانية أو اليسارية (وكلها اصطلاحات تحمل دلالات ضمنية إيجابية)، أخفقت في تقديم بديل جاد لاستنقاذ بلادها من أزماتها المتتالية. إن مجرد المعارضة « للتيار الإسلامي الرجعي » ليست كافية لتوفير المصداقية الإيديولوجية أو العملية. بل قد ثبت أن بعض الأحزاب « الليبرالية » هي أحزاب صديقة للأنظمة الديكتاتورية، وعلى اتصال وثيق بالغرب، وفشلت طوال الوقت في استيعاب عقلية مواطنيها وفهم ما يريدون، ثم لجأت إلى تبرير انقسامها وافتقاد التأثير السياسي بدعوى الوقوف يدا واحدة ضد « الإسلاميين ». وافتقرت هذه الأحزاب إلى القاعدة الشعبية وهي حقيقةيعلمها قادتهم علم اليقين. لذا فإن انتقادي لتيار الإسلام السياسي لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال قبولاً بوجهات نظر الفريق الآخر. وإنما الهدف وصف عمق أزمة الوعي السياسي في المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة، تلك الأزمة التي تطال كل الأفاق الإيديولوجية.
لقد حان الوقت أن لا نقف عند حدود الإسلام السياسي، وأن نتجاوزه إلى ما وراء ذلك. ونذكر حين ظهرت أولى بوادر تيارات الإسلام السياسي في بدايات القرن العشرين، وهي ترسي قواعدها وتتخذشكلاً منظما في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، كيف كان لدى غالبية هذه التيارات هدفاً ثلاثياً مشتركا يتمثل في : تحرير المجتمعات من الاستعمار، والعودة إلى الإسلام لمواجهة التغريب الثقافي، علاوة على بسط وتقديم الفرضيات والمبادئ الشبيهة بلاهوت التحرير في أمريكا اللاتينية، بمعنى العدالة الاجتماعية مع التركيز على تخفيف معاناة الفقراء والمقهورين. فكانت هذه التيارات محافظة من الناحية الدينية، قريبة من الناس على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، ورأت آنذاك أن الدولة القومية هي الأداة المناسبة لتحرير البلدان من نير الاستعمار بواجهاته المتعددة. وسواء اتفقنا مع هذه الحركات أو اختلفنا معها، فقد كان من السهل إدراك توجهاتها السياسية والإيديولوجية.
أما الآن فقد تغير العالم وكل ما حولنا يوحي بأن الحركات الإسلامية كالإخوان المسلمين وغيرها من الحركات الإصلاحية أخفقت في مواكبة التطورات العالمية على مر التاريخ في ظل التحولات الجارية في العلاقات الدولية، والأهم في ظل النموذج الجديد للعولمة. وقد اتضح أن سلطة الدولة، التي ظهرت في بادئ الأمر كوسيلة للإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، ما لبثت أن تحولت إلى غاية في حد ذاتها، ففسدت النوايا والأفعال لقطاع كبير من الحركات الإسلامية. واجتمعت هذه العوامل معا لتحدث انفصاما مع مرور الوقت بين المزاعم المتكررة للحركات الإسلامية التي كفلت لها تأييدا شعبيا كبيرا، وبين فشلها في التعامل مع تحديات الحقبة الجديدة. وبعد أن بدأت كحركات إسلامية قومية، أدى هوسهم بالدولة في نهاية المطاف إلى تجاهل الأزمات الاقتصادية الأساسية والتحديات الثقافية الكبرى (و الروحانية )، بل إنهم فشلوا حتى في التعاطي مع الأمور الأساسية المتعلقة بالحرية والمواطنة والاستقلال الذاتي. وبعد أن دُفع الإسلاميون إلى صفوف المعارضة، والتزموا تماما (بل سيطرت عليهم) رغبة إضفاء المشروعية على المشاركة في العملية الديموقراطية باعتبارها وسيلة واضحة جديرة بالثقة ذات مصداقية في أعين الغرب، تحولوا إلى قوى رجعية حافظت، باسم البراجماتية، وفي ظل التسويات المتعاقبة، على مرجعيتها الدينية مع تفريغها من مضمونها وإفقادها فعاليتها في التحرر الثقافي والاقتصادي والاجتماعي.
الحق أننا بعيدون كل البعد عن تفسير جديد لنصوصنا المقدسة أو لاهوت التحرير، هذا التفسير الذي يعطي الأولوية للفقراء والمضطهدين، وينظر في نهاية الأمر للعلاقات السياسية والاجتماعية في إطار حدودها الثقافية والاقتصادية. إن الإسلاميين اليوم ليس لديهم أي بدائل اقتصادية ذات مصداقية أو فعالية. ونظراً لأنهم وقعوا فريسة لهاجس الاعتراف الدولي بهم، فقد اضطروا للانحناء أمام إملاءات الاقتصاد الرأسمالي المهيمن. وأصبحت المرجعية الإسلامية عنصر رد فعل وقائي بامتياز، موجّه في الأساس نحو جوانب الإفراط المباحة من جانب الغرب والتغريبيين. وفقدت هذه المرجعية قدرتها على تقديم نهج أخلاقي للتربية والعدالة الاجتماعية والبيئة والثقافة والتواصل. وكانت هناك محاولات شعبوية متكررة لتطويع الدين لأغراض عاطفية تتعلق بالهوية أو لغايات انتخابية.
لا ريب أنه من الجيد الاحتفاء بالنجاح الاقتصادي الذي حققته تركيا، وكفاءة قادته الواضحة للعيان (على أن لا نغفل غياب بعض الحريات الأساسية، والميل لاحتكار السلطة)؛ ومن الجيد أيضا الإشادة بهذا التطور الذي لحق الفكر الإسلامي في مصر وتونس أو ظهور فكرة الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية بدلاً من الدولة الدينية الثيوقراطية. لكن كلماتهم تبقى مجرد شعارات رنانة وردود أفعال للهجمات التي تعرضوا لها بعد الوصول إلى السلطة، ولا تستند إلى مشروع سياسي حقيقي واضح. إن المشروعات التي قدمها الإسلاميون المحافظون أظهرت بما لا يدع مجالا للشك أنهم فشلوا مثلهم مثل خصومهم في إحداث أي تغيير حقيقي.
ربما حان الوقت لإعادة النظر في ترتيب الأولويات، وحدوث تحول في النموذج الفكري؛ ربما آن الأوان لتيار الإسلام السياسي أن لا يكون سياسيا في الأساس. فبعد قرن من الزمان قضاه في المعارضة، وبعد عقود من الوصول إلى السلطة أصبح تيار الإسلام السياسي مجرد إيديولوجية للوسائل والإدارة لا أكثر، ليس لديه ما يقدمه للمجتمع إلا ردود أفعال تجاه « العدوان الغربي » أو « أعداء الداخل ». إن المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة لن تتمكن مطلقا من تحرير نفسها طالما ظلت مقيدة بأغلال هذه الرؤية الضيقة المحدودة. لقد صار من الضروري تلبية حاجة الناس إلى معنى ومغزى، إلى الكرامة والروحانية، بعيدا عن أي مفهوم أثيري للإيمان والدين والقواعد. ومهمتنا هنا أن نعيد التفكير في الهدف الأساسي من الفعل الإنساني، وأن نرسم حدودا لمنظومة أخلاقية اجتماعية وفردية تكون بديلاً حقيقياً لهذا النظام العالمي الظالم القاسي. إن الحاجة لهذا المعنى، للحرية والعدالة والكرامة لم تكن أكثر أهمية ووضوحا عما هي عليه الآن، إذ بات واضحاً أن المسلمين في حاجةملحة اليوم إلى فلسفة شاملة للغايات، وإلى التحرر نهائيا من ربقةالإدارة الفوضوية للوسائل، التي اختُزل فيها تيار الإسلام السياسي. إن المجتمعات الإسلامية تتنادى إلى ثورة فكرية تكون جذرية في جوهرها،شجاعة في أهدافها ومقاصدها.
بعيداً عن أصحاب السلطة وعن الساسة والسياسة، آن الأوان أن نتصالح مع أنفسنا ومع عمق وامتداد منهجنا الحضاري الإسلامي وثراء معانيه، هذا المنهج الذي يؤسس القواعد في ضوء المقاصد، مقاصد الكرامة والحرية والعدالة والسلام. لا ريب أن مسلمي هذا العصر في حاجة ماسة لأن يفرضوا وجودهم من جديد. وفي سبيل ذلك لا بد من التأكيد على الروحانية، ولسنا نعني بهذا روحانية بعض المتصوفة ممن لا أرب لهم في المشاركة السياسية، وينتهي بهم الحال إلى ممارسة اللعبة السياسية والسير في دروب السلطة (والمستعمرين) وإنما المقصود البحث عن الذات والروحانية التي تتبناها الصوفية الحقّة فلا تفصلها عن الاعتبارات السياسية أو الاجتماعية أو الإنسانية (عبر حكم عادل رشيد). ولا يكفي التأكيد على أن الحرية ينبغي أن تسبق الشريعة. فإننا نفتقد إلى التأمل التام والتفكر العميق في مفهومالحرية في عصرنا الحديث، وفي المقاصد الشرعية التي ترفض أن تتحول الشريعة إلى مجموعة من اللوائح والقوانين المجردة. لا بد لنا من التأمل فيما قدّمه الشاطبي في نظريته حول مقاصد الشريعة، التي هي في الأساس فلسفة التشريع، ونبحث فيها عن مفهوم الحرية : نحنبحاجة إلى « فلسفة الحرية » لا تقبل التضييق والتقليص ولا أن تكون دوغمائية لا تعدو كونها ردود أفعال؛ نحتاج فلسفة تحررية شاملة واسعة تصلح للمرأة والرجل على حد سواء.
إننا بحاجة ماسة إلى مجموعة من شباب العلماء من الجنسين، مجموعة من المفكرين يظهرون قدراً لا بأس به من الشجاعة، يحترمون الرسالة وقواعد الممارسة الثابتة، لكنهم في الوقت ذاته يسعون سعيا حثيثا إلى التحلي بالجرأة الفكرية التي كانت لدى العلماء الأقدمين، تلك الجرأة التي أتاحت لهم أن يتركوا لنا مثل هذا التراث الإسلامي العظيم. وينبغي لهذا الجيل من شباب العلماء أن يتحرر من سلطان المؤسسات التي صاغتهم في قوالبها، تلك المؤسسات التي تحكمت فيها الدولة حتى أوهنتها وأفقدتها قواها الفكرية (كالأزهر وأم القرى في أيامنا هذه)، ويجب عليهم أن يشقوا طريقهم ويثبتوا وجودهم ويضفون على حركة المجتمع المدني معنى جديداً حتى يشعر الناس بهم وأنهم ما عادوا يكتفون بالجلوس في مقاعد المتفرجين أو يكتفون بالشكوى والتذمر، حان الأوان أن يعبروا عن سخطهم ونقمتهم أو يستكشفون سبلاً جديدة للحركة والعمل، ويقدمون روئ بديلة، في ظل التحلي بالصدق مع أنفسهم ومقاومة هذا النظام العتيق. إن التحدي كبير، لكن في سبيل التحرر من الهوس بالسياسة، لا بد أن تعرض تلك الحركة الفكرية مصطلحات جديدة لقوة مناوئة ترى أن تحرر الناس يتأتى عبر التعليم والمشاركة الاجتماعية وإيجاد البدائل للاقتصاد المهيمن، عبر الإبداع الثقافي والفني. لقد ذكرتٌ التحديات الفكرية التي تواجهنا في طرح الأهداف العامة الأساسية وتكوين رؤية عامة تضمن تحقيق العدالة والاستقلال الذاتي. وهنا لا بد أن تكون الأولوية لمسألة الانقسام الداخلي، والصراع بين السنة والشيعة والمذاهب الفكرية المختلفة (بل الصراع بين الجانب الديني والعلماني). إن القضايا التي تؤجج هذا الانقسام وتزيد من حدته هي أمور لا شك خطيرة لكنها سخيفة في كثير من الأحيان. وهنا لا بد أن يقوم العلماء والمفكرون الأحرار بواجبهم في التخلص من هذا الفخ (الذي يأبى بعض الإسلاميين في يومنا هذا إلا الوقوع فيه والغرق في لجته).
ولا تقتصر المقاومة هنا على المسلمين وحدهم. فمن الضروري إقامة علاقات بين الشمال والجنوب، وأن نخلّف وراءنا العلاقة المتحيزة بين « الإسلام والغرب ». لقد صار لزاما علينا أن نستكشف الإمكانات ونبحث عن فرص لعقد شراكات تربوية وتعليمية وثقافية جديدة مع شعوب أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا. إن الفكر الإسلامي الذي يستمد قوته من مبدأ طلب الحكمة والبحث عنها مهما كان مصدرها، صار معزولاً، متقوقعا على نفسه، جفت منابعه بعد أن أخفق في دراسة الحضارات والثقافات والمجتمعات الأخرى والتواصل معها والاستفادة منها. والإسلاميون ليسوا بمنأى عن هذا : فقد استحوذ الشمال على تفكيرهم ففقدوا تأثيرهم، وكذلك استحوذ عليهم الجنوب (أليست القبلة التي تركز النظر على نقطة مركزية وتمنحها معنى معين، تمنح نفس القيمة والكرامة للمحيط الخارجي كله؟)
إن الإسلاميين في عصرنا الحالي قد تبنوا رسالة محافِظة، رسالة تسعى للتكيف فقط. فلا بد أن يتحرر الضمير الإسلامي المعاصر من هذه الرسالة ويجدد التزامه بالقوة الإصلاحية الثورية للإنسان والمحتوى الروحي لتراثه الذي يدعو إلى المصالحة مع النفس والانفتاح على الآخر. ومن خلال التعرف بشكل أفضل على تراثنا، وتحديد الأولويات والاستفادة من الأدوات الجديدة المتاحة لدينا، عندئذ يمكننا أن نحقق أهدافنا المتمثلة في : الحرية والكرامة والتحرر. لكن المفارقة العجيبة والغريبة هي أن مسلمي اليوم، في ظل غياب الثقة في النفس، حالهم كحال السجان الذي يحمل في يديه المرتعشتين مفاتيح الخلاص من سجنه.
(ترجمة حسام صبري)






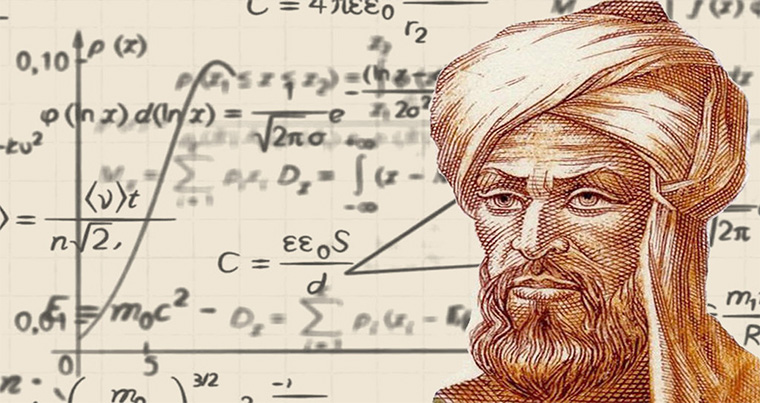




شكرا على المقال وعلى النظرة الشمولية للموضوع اتطلع ليكتب الدكتور طارق عن دور الوقف الاسلامي عبر مسيرة امتدت الف عام من السنين مثل فيها الوقف العمود الفقري لحضارتنا، واعتقد ان احياء الوقف واعادته من جديد الى الاذهان يساعد وبقوة باندماج فئات هامة من المجتمع لتحقيق الاهداف التنموية والحضارية التي نتطلع اليها