في عصر العولمة والحداثة، طُرحت قضايا التنوّع والتعددية على بساط البحث والنقاش بشكل غير مسبوق، مع أننا نبدو منغلقين داخل خصوصياتنا واختلافاتنا أكثر من أي وقت مضى. إن العالم الكونيّ ما هو إلا قرية، هذا ما يقولونه، لكن هذه القرية مأهولة بسكان غافلين، سكان يتجاهلون هويتهم الخاصة بقدر ما يتجاهلون هوية جيرانهم. وبدل الاحتفاء بالثروة والغنى، أدى هذا الوضع إلى صراعات خجولة مخيفة كامنة: إنه « صراع الجهل » ، كما يسميه ادوارد سعيد؛ والذي أظنه أنا صراع التصورات. إن مفهوم التصور أكثر إثارة من مفهوم الجهل: فالجهل في الحقيقة يمكن أن ينتج عن التصور، لكن التصور يعبّر عن علاقة المرء بنفسه وبالآخرين، وهو شيء لا يتعلق بالضرورة بالمعرفة وحدها، إذ يشمل المشاعر والأحاسيس والقناعات؛ أي بكلمة أخرى هو يشمل علم النفس. إننا نفتقر للثقة، الثقة بأنفسنا، وبالآخرين، الثقة بالله و/ أو بالبشر، والثقة بالمستقبل. ونتيجة لذلك يغزو الخوف والشك والريبة قلوبنا وعقولنا دون اكتراث منا – ويصبح « الآخر » مرآتنا السلبية التي تمكننا اختلافاتنا معها من التعرّف على ذاتنا، أو « تحديد » من نكون، كي نتمكن في النهاية من إيجاد بعض الطمأنينة في مواجهة انهيار المدارك (المعارف). تحوّل هذه الديناميات تفكيرنا – حسب المفهوم الباسكالي – عن أنفسنا، وعن جهلنا، عن مخاوفنا وشكوكنا وهواجسنا؛ فمجرد وجود « الآخر » يبرر ويشرح شكوكنا . إننا نغذّي إسقاطاتنا وننسى أننا نفتقر إلى الخطط، أي: المشاريع.
لذا علينا العودة إلى بعض الحقائق الأساسية – البسيطة والعميقة – ونبدأ بطرح بعض الأسئلة الضرورية والبحث عن المعنى. علينا أن نسبر أغوار أنفسنا وأن نتقدّم بتساؤلات، ونقد بنّاء، وتعقيد معرفي. ولا يمكن تحقيق هذا إلا بوضع فرضية مبدئية للحقيقة، التي سوف تفرز تلقائياً موقفاً يتسم بالحياء الفكري والتواضع: كل واحد منا يرى العالم من نافذته/ نافذتها الخاصة. هذه النافذة ما هي إلا وجهة نظر تلوح عند الأفق، وهي إطار مقيّد بتوجهاته وحدوده، ولهذا هو فاسد نوعاً ما – كل هذا يلوّن العالم أمام عيوننا. على المرء أن يبدأ بكل تواضع بتقبّل فكرة أن ما لدينا فقط هو وجهات نظر، بالمعنى الحرفي للكلمة، وأننا انطلاقاً من وجهات النظر هذه نبني أفكارنا، وتصوّراتنا وخيالنا. إن الوصول إلى قناعات تمتلك النسبية الضرورية لتوقعات المرء، تعني دون شك الارتياب بكل شيء أو عدم الوثوق بشيء. بل على العكس، قد يترتب عنها ثقة خالية من الغطرسة، وفضول صحيّ خلاّق تجاه تلك النوافذ الأخرى اللامتناهية، التي ينظر منها الآخرون منها إلى الكون نفسه.
لكن وفي ظل الظروف الحالية، ليست التصورات وحدها التي تختلف، بل وصل المرء إلى مرحلة الشك في أننا جميعاً ننظر إلى الكون نفسه، وأننا جميعاً نواجه نفس الأسئلة، وأننا كلنا نجسد ونتشارك في الإنسانية. إن الحياة في « القرية العالمية »،التي أصبحت الفردية أبرز مميزاتها، قادتنا إلى الشك ببقاء آثار من الفلسفة خلف حسابات نزعتنا إلى السلطة واهتماماتنا الشخصية. ماذا يمكن للأنا أن تستخلص من الأنانية وحب الذات؟ وكما تقدم ذكره فإن هذه هي النقطة التي يجب على الأنا أن يبدأ بطرح الأسئلة على نفسه، ومن خلال التوتر الحميم والمواجهة مع الكون المحيط، يفهم أن التنوع ليس مجرد حقيقة بل هو ضرورة، إنه أفق، وهو أمل. علينا أن نشتغل على تغيير طريقتنا في النظر إلى الأشياء، وعندها فقط ومن خلال وجهة نظرنا الواثقة، نضع في الاعتبار تصوّر الآخر ونبدأ باختبار التواضع والتعاطف الفكري والشعور بالمسؤولية. يمزج التنوع الخارق بين إدراك التنوع البشري الضروري وبين الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية.
وهنا أرى مسارين بديلين يلوحان في الأفق: الأول هو أن نختار التنقل من نافذة إلى أخرى، من فلسفة إلى أخرى، ومن دين إلى آخر، وأن نجرّب كل واحد منها على حدة، كي نفهم التقاليد والمدارس المتعددة بتعاليمها ومبادئها، التقاليد والمدارس التي تحرّك الأفراد الذين نتشارك وإياهم حيّز الحياة. من واحد إلى آخر، ومن ذات إلى أخرى يجد المرء نفسه وهو يضع يده على بعض أوجه التشابه، وبعض النقاط والقيم المشتركة. أما المسار الثاني فهو الدرب الذي يأخذنا إلى قلب المشهد المشترك الموجود أمامنا وبالتالي يدعونا إلى تقليب أبصارنا باتجاه النوافذ المحيطة. وهنا لا تكون الفكرة في التركيز على تعددية الناظرين، بل على الخوض في الشيء المشترك الذي يُنظر إليه، والتمسك بتنوّع وجهات النظر من خلال جوهر التشابه بينها. بمجرد تقبلنا لفكرة أن وجهة نظرنا هي نافذة ملوّنة تطل على الحقيقة الواسعة المشتركة، عندها علينا أن نسافر وأن ننطلق بحرّية وأن نغوص في المحيط، وأن نبحر، نتوقف، ننكفئ، نقاوم، وأن نبحر من جديد ونتذكر أنه لا وجود للمحيط دون وجود شطآنه المتعددة، وأنه ليس أمامنا سوى فرصة البقاء على قيد الحياة. اخترت في هذه المقالة أن أركّز على ما هو مشترك كي ألمس، بثقة وتواضع، المياه المشتركة التي يحدّق إليها عدد هائل من الناظرين. إن التعامل مع موضوع التنوّع يتطلب تطوير فلسفة، وعقلية هما عبارة عن انغماس في الأهداف التي تسمح لنا بالوصول إلى المواضيع، والبشر بتقاليدهم، وأديانهم، وفلسفتهم، وجمالياتهم، و/ أو نفسياتهم. المرء بحاجة لأن يضع في الحسبان بعض المفاهيم والأفكار والمثل المشتركة، والغوص فيها كي يعرف رأي الفلسفات والأديان المختلفة فيها. هذه أفضل طريقة للعودة إلى الذات.
دعونا نبدأ بالتفكير بالتوتر الواضح بين الكونيّة والتنوّع. ستساعدنا هذه الخطوة الأولى على البدء بفهم ما هو مشترك، وما هو خصوصي، والطريقة التي يستطيع بها المرء استخدام التنوّع كأفضل طريقة توصله إلى جوهر الكونيّة.
تتردد كلمة كونيّ في كل مكان يذهب إليه المرء، إذ يبدو وكأنه في هذه الأوقات التي تسود فيها النسبية العامة، هناك حاجة مشتركة للإصرار على نوع من النظر إلى المطلق، إلى نوع من المرجعية تتجاوز تعددية وجهات النظر، أو بشكل غير مباشر، انعدام المرجعية. في عصر postmodernity و postmodernism (كنوع من النقد لـ postmodernity)، واللابنائية، وبينما نحن نشهد ازدهار المفاهيم التي تبشّر بنهاية النظم والقوانين المنطقية، والقصص المترابطة، وأيديولوجيات الشمولية السياسية، والغائيات البشرية (كلها تتسبب بانهيار العلاقات السابقة بالحقيقة)، تبرز حاجة ماسة ومتكررة إلى فكرة الكونيّة، كي تعبّر وتصف وضع بعض القيم والمبادئ المعينة. وبالنظر إلى الأمر من بعيد يبدو أن الشعور بخسارة المعنى والمعالم يتم التعويض عنه بإرادة قوية عازمة على تأكيد ونقل أو امتلاك ما هو كونيّ. هذا يؤثر بشكل كبير على العلاقة بين الحضارات، باعتبار أن الأفراد الذين يمثلون حضارات مختلفة، يعوّضون عن الفوضى الداخلية بالمنافسة على تعريف ما هو كونيّ بالنسبة للآخرين. إن ما يختبره الـ postmodernist يحرمنا من إقامة علاقة داخلية مع أنفسنا، أي اليقين، مما قد يعود إلينا من خلال علاقتنا مع الآخرين، عن طريق فرض الكونيّة. هناك نوع من المنطق الفكري وحتى النفسي في أقنية الاتصال هذه، والمعني في هذه المسألة هو الشك والسلطة دائماً.
ما المقصود بمصطلح « كونيّ »؟ وكيف نستطيع تكريس كونيّة التجربة البشرية؟ هل نفعل ذلك بطبيعة أسئلتنا المشتركة، أم بأوجه الشبه المحتملة لإجاباتنا المختلفة؟ أم في الاثنين معاً؟ ومن أين ينطلق المرء عند رؤية ما هو كونيّ وتحديده والتعبير عنه؟ كل هذه الأسئلة جديدة دون شك؛ وقد تمت صياغتها بطريقة أكثر طبيعية (وتكراراً) في الفلسفة الغربية مع بزوغ مذهب العقلانية المستقلة لرينيه ديكارت (1596 – 1650) وخصوصاً عند باروك سبينوزا (1632 – 77). بدأ هؤلاء الفلاسفة بطرح سؤال أساسي هو: هل نستطيع أن نضع الكونيّ « في القمة » أم نعتبره بديهياً بتحديد كائن، أو جوهر، أو فكرة تُعتبر هي سبب كل شيء؟ أم أن الكونيّة هي عملية تتجه « من الأسفل إلى الأعلى »، ومن خلالها يقوم المنطق البشري بتعريف السمات العامة التي يشترك بها البشر والعناصر على اختلافها وتنوعها؟ وقد أطلق أحد أتباع سبينوزا وهو ج. و. ف. هيغل (1770 – 1831) فكرة النوع المثالي للكون الذي يجسّد « السبب »، أو البيانات الفائقة للكائنات والأشياء باسم « الكونيّ الملموس ». وهذا المصطلح يتعارض مع « الكونيّ المطلق » الذي يُبنى باستخدام المنطق الاستنتاجي في تعريف القواسم المشتركة للكائنات والأشياء . وهو أيضاً ما وضعه آرثر شوبنهاور (1788 – 1860) حيّز التنفيذ في تمييزه بين الفكرة والمفهوم: وهي مفاضلة أفلاطونية للأصل واختلاف الطبيعة أو المظهر الدنيوي ضمن جوهر الكونيّ نفسه. وفي صميم الفلسفة الغربية كما هو الحال في الحوار بين الحضارات أو الأديان، لا نزال معنيين بهذا التساؤل حول أصل وطبيعة ما هو كونيّ.
كل الأعراف الروحية (غير التوحيدية) أو الدينية تقدمت بشرح لما هو كونيّ. وبطريقة أو بأخرى أشارت إلى الكائن، أو الفكرة، أو الطريقة (الكونيّ الملموس)، وتقليدياً حددت « المنبع » أو البديهي الذي يحكي عن جوهر التجربة البشرية. وسواء أكان المرء مؤمناً بأن الطبيعة تسكنها روح واحدة أو عدة أرواح (كما هو الحال في تقاليد القبائل الأفريقية)، وأن على المرء أن يحرّر روحه من الأنا ومن سجن التجدد الأبدي من خلال البدء بقهر النفس _كما هو الحال في البوذية_، أو أن على المرء أن يقر بوجود (الواحد) ويقوم بممارسة الشعائر _كما هو الحال في الأديان التوحيدية_، كل ما تقدم يفترض ضمنياً، وللجميع، أن الحقائق والاحتياجات الأخلاقية والشعائرية على التوالي تُعتبر قيماً كونيّة. فالحقيقة ، كقيمة ذات مغزى قائم بذاته هي منطقياً ذات مغزى للجميع. أما بالنسبة للروحانيات والأديان التي تحدد منبع الكونيّة فهذا لا يعني بالضرورة أن بناء الكونيّة من خلال استخدام المنطق ليس شرعياً، أو أن المسارين لا يمكن لهما أن يتقاربا بطريقة ما. قد لا يكون المنهجان متنافيين، لكن هذا من جديد يعتمد على نزعات العقول المعنية بعمليتي التأمل والبحث. فالأمر في الحقيقة ليس مجرد تحديد فهم المرء لما هو كونيّ، بل وعلى نفس القدر من الأهمية هناك المقدرة على الإصغاء _رغم أن المرء قد لا يفهم دائماً ما يسمع_ إلى الأسباب وراء آراء الآخرين بما هو كونيّ – الإصغاء إلى ما يقولون، والتفكير بالأساس الذي ينطلقون منه في قولهم ذاك – والاستعداد لفهم الأشكال المختلفة للكونيّات: الكونيّ المتعالي، والكونيّ الملازم، والكونيّ الحميم، وكونيّ القلب، وكونيّ المنطق حتى الكونيّ المنعدم الفارغ الذي لا معنى له.
لذا فإن فكرة الكونيّ تتحدد في المقام الأول بواسطة طرق ومسارات وحالات ذهنية متنوعة. ومع هذا فإن البشر مفعمون بالتطلعات المتناقضة، وإرادتنا في تأكيد تفردهم وخصوصيتهم لها نفس القوة كحاجتنا إلى الوصول إلى حقائق عامة أو جوهر مطلق يتجاوز التنوع والاختلافات. إذا بدا القلب تواقاً لحب لا مثيل له، فإن العقل يصبو إلى اكتشاف الجوهر المشترك لكل أنواع الحب. إن الفردي هو كونيّ والكونيّ هو مشترك؛ ومع هذا لا تظهر إلا التناقضات والمفارقات. إن الكونيّ هو حاجة بقدر ما هو ضرورة، لكن الفلسفات الحديثة قد تعمل على تفكيك النظم الكونيّة والقوانين المطلقة وتدرس الحداثة من حيث النسبية ووجهات النظر والحقائق المتعددة، إن الضمير الفردي والجماعي هو دائماً في حاجة للمعنى واليقين ووحدة القلب و/ أو العقل وربما المصير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ادوارد. و. سعيد، “The Clash of Ignorance,” The Nation (October 22, 2001): 11–13
بليز باسكال، Pensees, trans. A. J. Krailsheimer (London: Penguin, 1995), 171.
هيغل G. W. F. Hegel, Hegel’s Science of Logic, trans. A. V. Miller (Amherst, NY:
Humanities Press, 1989), 606.






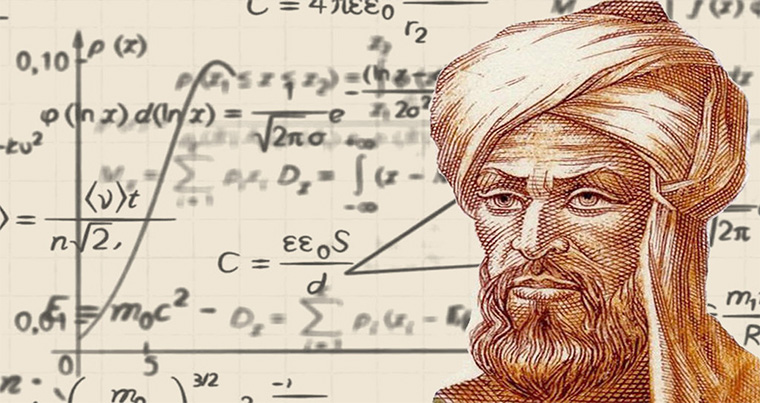




من أروع ما قرات ماشاءالله
شكرا شكرا شكراً جزيلا
, فعلأ أنه لأ خيار لدينا سوى البقاء على قيد الحياء.
و الغريب فى ألأمر انه على حد تصورى اننا وصلنا الى انسب وقت فى تاريخ البشريه لكى نشفى فضولنا من الأخر الزى طالما ما توجسنا منه وبنينا عليه أساطير اساسا نابعه من مخاوفنا منه و جهلنا به. كما قلت انه الأن و اخيرا قد سنحت لنا الفرصه لكى نرى بعضنا البعض عن قرب و معرفه و ادراك فكيف نسمح للجهلأء و من لأ يعلمون ان يقودونا الى الوراء. اصلأ لما نسمح للجهلأء ان يقودونا من بادى لأمر.