من يدّعي ملكية الكونيّ؟ نلاحظ أنَّ هذا السؤال يكمن ضمن حدود الرغبة في اليقين التي يسعى دائما إليها الضمير الفردي والجماعي. أثناء دراسته الدقيقة لـ « أصل التفاوت بين الناس » ومن ثم قوة العلاقات، تخيّل جان جاك روسو (1712 – 78) حدثاً فردياً مثل النقطة التي بدأت منها فكرة الملكية، فكتب: « أول إنسان أحاط قطعة أرض بسياج وفكر وقال هذه الأرض لي، ووجد أناساً سذّجاً آمنوا بذلك وسلموا له به، هذا الإنسان هو أول مؤسس للمجتمع المدني. » ثم أضاف: « كم من الجرائم والاغتيالات، وكم من الرعب والمحن كان لأي إنسان أن ينقذ البشرية منها لو خلع ذلك السياج وغطى تلك الحفرة وصرخ في الناس خذوا حذركم، ولا تسمعوا لهذا الدجال المدعي، فأنتم هالكون إذا نسيتم للحظة بأن الأرض لنا جميعاً، وأن الأرض نفسها ليست ملكاً لأحد. » في هذا القول يعبّر روسو عن مفاهيم « المشاركة » التي تنص عليها الروحانيات الأفريقية والهندية الأميركية، إضافةً إلى انتقاده للملكية التي تطرّق إليها لاحقاً كلٌ من كارل ماركس (1818 – 83)، وفريدريك انجلز (1820 – 95)، والاشتراكية العلمية.
ما نقوله هنا هو أن الاستيلاء على السلطة من خلال التخصيص غير المبرر هو بالنسبة للممتلكات العامة تماماً مثلما هو الاحتكار الكونيّ بالنسبة للقيم. وقد ادعى أنطوان دو سانت- أكزوبري (1900 – 44) بتفاؤل كبير أن « الاعتقاد بما هو كونيّ يمجّد ثروات معينة ويربط فيما بينها. » ومع هذا فإن احتفالاً كهذا يمكن أن يكون لسوء الحظ مصدراً للخلط بين « عقيدة الكونيّ » وعقيدة الذات. لا يتردد البعض في إدعاء ملكيتهم للقيم الكونيّة فيعلنون بقوة وغطرسة أحياناً قائلين: « هذا لي ولشعبي. »
انطلاقاً من كون البحث عن الكونَّيّ حاجة مشتركة، فقد بدا في بعض أحيانه سعي لملكية مطوّقة وحصرية، ولأن يكون ذلك أداة للسلطة والهيمنة، يتخلّق عنها الحروب والموت. فالحروب الصليبية، والجهاد التوسعي العدواني، والتحوّل الديني القسري، والبعثات التبشيريَّة، والاستعمار وغيرها الكثير من « المحن » و »الأهوال » كلها أمثلة على ذلك. على المرء إذن أن يصّر بكل عزم على أن ما هو كونيّ يكمن ببساطة في معنى: الثمار لنا جميعاً، لكن الأرض نفسها ليست ملكاً لأحد.
هناك عدة طرق لتخصيص الكونيّ وادعاء احتكاره ثم تأسيس هرمية من القيم والحضارات والثقافات. وأحياناً تشمل العملية إملاءات لأفكار محددة من الحقائق الكونيّة على الآخرين، بطريقة أو بأخرى، « لمصلحتهم، » طبعاً. في مملكة الكونيّ يتألف أكثر المواقف طبيعية، رغم أنه ليس أقلها خطراً، من تقليص احتمالات وجود آراء شخصية: فالحقيقة التي أؤمن بها هي الحقيقة التي يجب أن يؤمن بها الجميع، والحقائق التي تنبع من هذه الحقيقة هي من باب أولى، كونيّة. في هذه الحالة يكون النظام قد فُرض من الأعلى، مثلما يتقبّل الإنسان بثقة كلام الله أو المعبود المطلق. كل الأديان والروحانيات تُواجه بخطر الخداع، الذي يكون في العادة ادعاء النظر إلى جبل القيم الكونيّة من فوق، متجاهلاً بذلك وجود الأطراف المتعددة، التي تشكل جوهره، ألا وهي منظوره البشري.
أما بالنسبة للكونيّ المبني على الملكات العقلية المشتركة، فإن الظاهرة تختلف تماماً لكنها مع ذلك تواجه أخطار منطق التملك ذاتها. بالتقدم في اتجاه الخير العام، يقرّ المرء بوجود آراء ووجهات نظر متعددة، كما يقرّ بالحاجة إلى المسلّمات، والشكوك، حتى إلى المفارقات المتناقضة للمنطق التحليلي. ويمكن للمرء أن يوطّد مبادئ الثابت والمتحرك، كما فعل سقراط (حوالي. 469 – 399 ق.م) أو أرسطو (384 – 22 ق.م)؛ أو أن يضع إطاراً ونظاماً هرمياً للحقائق بحثاً عن الحقيقة الأولى، مثلما فعل أبو يوسف يعقوب بن اسحق الكندي (حوالي. 801 – 873) ومن بعده أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا (980 – 1037)؛ أو أن يحدد منهجاً عقلانياً صارماً لاستقراء الثوابت كما فعل ديكارت؛ أو أن يبدأ بملاحظة الحقائق المعقولة التي افترضها التجريبي بيركلي (1685 – 1753) وهيوم (1711 – 1776). يمكن للمرء في الحقيقة أن ينطلق من هذه الدراسات الفلسفية والمسلمات الكثيرة وأن يبني العديد من نظم الحقيقة؛ وبصرف النظر عما يقع عليه الاختيار فإن التعددية المنفذة تشير إلى نسبيتها. لذا وحين يبدأ المرء بتسلق جبل الحقيقة فعليه أن يعترف أن هذا الجبل لا يُظهر للعين إلا جانباً واحداً من جوانبه.
يبقى هناك خطر التفكير في أنه رغم وجود عدة جوانب للجبل، إلا أن طريقاً واحداً هو الذي يؤدي إلى القمة – وهو الطريق الذي نسير عليه « نحن ». لأن تقبّل تعددية فرضيات الحقيقة نظرياً لا يعني حجب خطر اعتقاد المرء أن اليقين والحقيقة محصوران به وحده، عند التطبيق العملي؛ كما لا يعني إصدار حكم نهائي وأتوماتيكي على الأشخاص الذين يسيرون على نهج مختلف. إنهم ضحايا « الاستبعاد » حسب ما جاء في تصنيف فئات البشر للودفيغ أندرياس فيورباخ (1804 – 72)، أو هم عقول استعمرتها « المعتقدات السيئة »، أو أنهم « حقيرون » أو « أوغاد جبناء » كما أسماهم جان بول سارتر (1905 – 80). إن البنى العقلانية ليست معفاة من ادعاءات اللياقة بالحقيقة والكونيّة. عند اقتناعنا بأننا مسلحون بملكات منطقية مشتركة مع الجميع، يصبح من المنطقي التفكير، نتيجة لذلك، بأن القيم التي نكتشفها أو نفصّلها ستكون بشكل طبيعي هي ما يفكر به الجميع.
وبالتالي فإن فرضية كونيّة المنطق قد فرضت نفسها منطقياً على كل الكائنات العاقلة. وإن لم يكن الواقع هكذا فعلى المرء أن يحسب الوقت والارتقاء التاريخي الذين يجب اختبارهما قبل الوصول إلى تطور كامل. هذا ما عناه أوغست كومت (1798 – 1857) في نظريته حين ذكر المراحل الثلاث للتطور الإنساني (اللاهوت، الميتافيزيقيا، والفلسفة الوضعية). بالنسبة له هناك طريق واحد مطلق لكشف الحقيقة، لا عدة طرق، وقد تقدمت بعض الحضارات ببساطة أكثر من غيرها في هذا المضمار. ما طوّره كومت، بوضعه الفلسفة الوضعية كمرحلة نهائية مطلقة، عبّر عنه في السياسة إعلان فرانسيس فوكوياما لما أسماه « نهاية التاريخ »عام 1989، مع الانتصار المرتقب للغرب الرأسمالي العلماني، أو للديموقراطية الليبرالية، بعد الحرب الباردة. إن نهاية التاريخ لا علاقة لها بالتنوّع إذن، بل بالارتقاء: وعلى نفس طريق التقدم البشري، نرى أن البعض هم أكثر تقدماً من البعض الآخر وبالتالي فهم قادرون على الوصول إلى الطريق الكونيّ قبل غيرهم. لا يمكن للمرء أن يلوم دعاة هذا المنهج بالاستيلاء على أي شيء، أو اتهامهم بالحيازة غير المشروعة للملكية، أو بالتقدم لاحتكار ما هو كونيّ. وهم يعترفون بنظرية روسو إن ثمار الأرض هي للجميع بينما الأرض ذاتها ليست ملكاً لأحد. لكن يبدو أن هناك طريقاً واحداً يؤدي إلى القمة، ويبدو أنهم أول الواصلين.
إنها مسألة رأي، إذ يُعتبر أصحاب العقول المتدينة أو المؤمنون و/ أو أصحاب القناعات الراسخة غالباً الأكثر عرضة لإغراء الاستيلاء على ما هو كونيّ وإدعاء احتكاره. هذا ليس بخطأ: فحين يؤمن المرء بالله أو بطريق الحق والاكتفاء، فإنه يصبح ميّالاً وبقوة للتحدث عن، أو باسم، الله الذي يؤمن به، أو باسم الحقيقة الروحية التي يخلص لها. وما تاريخ الأديان والحضارات كلها التي قادها هؤلاء سوى برهان كاف على مسألة الاستيلاء والتخصيص هذه؛ إن تاريخ الحروب الدينية مليء بمثل هذه الادعاءات. لكن من الناحية الأخرى فقد سُمع عن العديد من المواقف المعاكسة: فبعض العقول المتدينة أو بعض التعاليم الروحية كانت مدركة تماماً لهذا الخطر التحقيقي الاستبدادي، فبدأ أصحابها يركزون على قيمة التنوع والإصغاء وعلى الرفض القاطع للإكراه، واحترام تعددية الأديان والطرائق والآراء. وعلى العكس فقد انتهى الحال ببعض العقلانيين المتيقنين، والمشككين، والملحدين أو من ذوي الفكر الإلحادي، الذين يُعرفون بأصحاب العقول المنفتحة، انتهى بهم الحال للتفكير بأن فكرة انفتاحهم نفسها تعطي مكانتهم وقيمهم نوعاً من التفوق الطبيعي. بعد الثورة الفرنسية التي يُقال بأنها وليدة عصر المنطق، مرّت عبادة العقل بالكثير من الفترات العصيبة. وانجرف بعض العقلانيين أو المشككين، ناقلين فوضى انفتاحهم وشكهم بذاتهم للآخرين، يحرّكهم نفس الإغراء الحصري: فهم لا يمانعون في وجود الحقيقة الكونيّة، لكنهم ينكرون تعددية هذه الحقيقة. هذه هي المفارقة التي قدمها هؤلاء الذين يعتقدون أن هناك طريقة واحدة للانفتاح.
إن الميل لاحتكار الكون/ أو الطرائق الكونيّة دون اكتراث، لا يقتصر على الكونيّ بحد ذاته، بل يتعلق برغبة بعض العقول في ادعاء تصوّره. وفي الحقيقة فإن حالة الذهن هي مكمن الرأي، وفي الحالات التي مال بها إدراك ما هو كونيّ باتجاه الاحتكار، كان يبدو أن الإغراء العقائدي كان يسيطر على الذكاء. إن الأذهان العقائدية ليست متدينة وليست أذهاناً مؤمنة؛ بل ربما تكون الأكثر عقلانية. إن الخصائص المميزة للأذهان العقائدية هي أنها تنظر إلى الأمور من زاوية حصرية، ثابتة ومطلقة. لذا وبصرف النظر عن كون المرء متديناً أم لا، فقد يخلط الذهن العقائدي بين نفسه وبين الله – ويبدأ بالحكم من فوق، باسم الأبدية – تماماً كما قد يعتبر نفسه صاحب الرأي المطلق (تناقض في المصطلحات، كما يسميه هنري بيرغسون ]1859 – 1941[) والمركز الفريد لما يُرى ولما يجب أن يُرى. الكونيّة هي مثله الأعلى، لكن التفرد هو حلبته – حقيقته هي وحدها الحقيقة، ومنطقه هو الصحيح فقط، وشكوكه وحدها هي الموثوقة.
وعلاوة على ذلك فإنه من الخطاً اعتبار الذهن العقائدي ذو رأي واحد أو وجهة نظر واحدة. بل على العكس، فبقوله أن حقيقته الخاصة هي فريدة، وأن طريقته الخاصة حصرية، وأن ما هو كونيّ بالنسبة إليه هو الشيء الوحيد المناسب للجميع، فإنه يشترط في الوقت نفسه أن كل من لا يشارك في هذه الحقيقة أو تلك الطريقة أو ذاك الكونيّ فإنه يعيش، وهذا أقل ما يُقال، في عالم من الاغتراب المطلق، أو، وهذا أسوأ ما قد يُقال، مرتكب لإثم عظيم. يصبح هذا الإطار المبسّط للذهن معقداً بشكل مفاجئ. والمحيّر، بعد كل هذا، أن نرى – في خضم الحداثة والعولمة – صعود حركات جماهيرية، مثقفة نوعاً ما، وعاطفية بشكلٍ ما، لكنها عاجزة على نحو عجيب، عن إدراك تعقيد الآراء، والطرائق والمسارات. ويبدو وكأن تواصل الجماهير بقدراتها الهائلة وضغوطها النفسية وتعقيداتها غير المنضبطة، وقدرتها على التأثير، نجح في تشكيل كائن بشري جديد مصغّر، بصرف النظر عما إذا كان هذا الكائن شرقياً أم غربياً، شمالياً أم جنوبياً. إننا نشهد مولد العقل المزدوج – الذي يخلو وبشكل متزايد من الأفكار والهيئات المعقدة، والذي يقتنع بسهولة بـ « الحقائق » التي تتكرر على أسماعه وتستعمره التصورات والانطباعات – المبهمة بشأن ذاتها بقدر ما هي واضحة ونهائية بشأن الآخرين.
____________________
الهوامش:
جان جاك روسو The Social Construct and Discourses, trans. G. D. H. Cole (London: Everyman, 1973), 84.
أنطوان دو سانت اكزوبري Pilote de Guerre (Paris: Éditions Gallimard, 1942), 84.
جان بول سارتر l’Existentialisme est un humanisme (Paris: Editions de Minuit, 1941).
بالنسبة لسارتر فإن كلمة “salaud” تشير إلى الأشخاص الذين يبحثون عن أعذار تجنبهم تحمل المسؤولية تجاه الإنسانية. وبسبب افتقارهم للشجاعة فإنهم يلومون « الآخر »، أو « المجتمع »، أو « الظروف التاريخية » لتبرير تصرفاتهم وأحياناً يلومون غياب هذه الأسباب.
فرانسيس فوكوياما،“The End of History?” The National Interest 16 (1989). وقد توسعت المقالة لاحقاً فأصبحت كتاباً بعنوان The End of History and the Last Man (New York: Free Press, 1992).






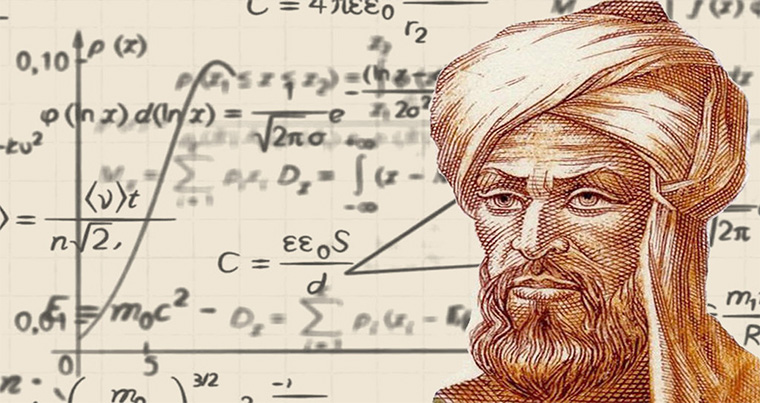




و أنا أقرأ هذا المقال الذي بالأمكان وصفه بالفلسفي, قلت في نفسي لماذا أختار الله عز و جل محمدا ذلك الأمي ليكون رسولا في الأميين؟
أن ما يعنيني في هذا المقال كأنسان ينتمي جغرافيا ووجدانيا الى الفضاء العربي الأسلامي الممتد من طانجا شرقا الى المنامة غربا, هو جدلية الفوضى و النظام, أو أن شئت أيبيستيمولوجية حتمية تطور التنظيم المجتمعي مع حركة التاريخ, لأن الأنسان بطبعه لا يمكن أن يعيش في الفوضى.
بالرجوع الى المجتمع الذي يعنيني, كل ذي عقل سيلحظ و لا ريب أنه يتبنى مرغما أفرازات الحداثة و لكنه يرفض تطوير سلوكه كي يتلاءم مع مقتضيات الحداثة.
من ذلك مثلا, قد نتبنى النظام الجمهوري, ولكننا نرفض القيم الجمهورية, وقد نتبنى الديموقراطية و لكن نرفض التداول السلمي على السلطة؟؟
وقد نعلم المرأة ونرفض خروجها للشغل وهكذا.
لقد صدق أينشتاين حين قال: من الغباء أن تجري تجارب بنفس الطريقة و نفس الأسلوب و مع ذلك تنتظر نتائج مختلفة.
En parlant de valeurs universelles et de raisonement pratique ,Mr ramadan pourai t il nous eclairer sur la pensée de .Nietzsh et kant
Bonsoir,
Je trouve que cet article est interéssant,toutefois,il faut se méfier de certains noms à titre d’exemple :Rousseau qui a écrit des oeuvres importantes certes,mais ,doit ne doit pas prendre en considération sa biographie et particulièrement son rôle paternel au sein de sa famille.
A’ ce moment -là ce sont les actes de Rousseau en tant que responsable qui priment et qui dissolvent toutes ses théories .