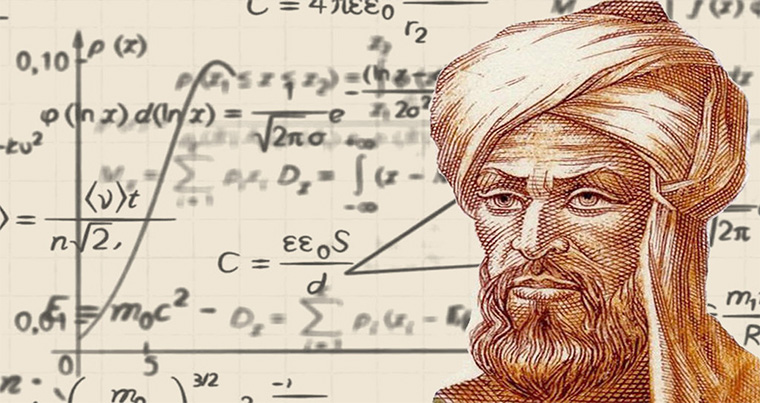ترجمة صلاح شياظمي
لقد أصبحنا نسمع عن الكونية في كل مكان. كما لو كان واجبا، في هذا الزمن الذي تسود فيه النسبية العامة، الدعوة إلى الكونية كشكل من أشكال المطلق، أو كمرجعية تسمو على جميع وجهات النظر، أو تعكس بشكل غير مباشر انعدام المراجع. ففي الوقت الذي تزدهر فيه المفاهيم التي تؤكد نهاية النظم والأنساق المنطقية، خاصة الرواية أو السرد المتناسق، ونهاية أيديولوجيات الشمولية السياسية والغائيات الإنسانية، في زمن ما بعد الحداثة والتفكيكية وتضخم المفاهيم التي أدت إلى إسقاط مجموعة من الأفكار المتعلقة بالحقيقة، ها نحن أمام الكونية التي أصبحت حديث الجميع، جاءت لتعبر عن بعض القيم والمبادئ. فإذا نظرنا من بعيد، اتضح لنا أن الشعور بفقدان الجوهر والمعالم على المستوى الداخلي، تم تعويضه على المستوى الخارجي ( خصوصا في علاقاتنا مع الحضارات الأخرى) بعزم و إرادة قوية لامتلاك الكونية وترجمتها على أرض الواقع. فما أخذته منا تجربة ما بعد الحداثة سنسترده عبر المطالبة بالكونية. يتضح أن هناك منطق فكري معين ونفسي كذلك، يحكمه وجود بعض الشكوك كما تحكمه الحاجة إلى السلطة.
ما المقصود بمصطلح « كونيّ »؟ وكيف نستطيع تكريس كونيّة التجربة البشرية إذا كنا نسعى جميعا إلى البحث عن المعنى والحقيقة والسلام ؟ هل نفعل ذلك بطبيعة أسئلتنا المشتركة، أم بأوجه الشبه المحتملة لإجاباتنا المختلفة؟ أم في الاثنين معاً؟ ومن أين ينطلق المرء عند رؤية ما هو كونيّ وتحديده والتعبير عنه؟ هذه الأسئلة ليست جديدة بدون شك؛ فقد تمت صياغتها بشكل عادي وبتكرار في الفلسفة الغربية مع بزوغ مذهب العقلانية المستقلة لديكارت وخصوصاً عند سبينوزا. بدأ هؤلاء الفلاسفة بطرح سؤال أساسي هو: هل نستطيع أن نضع الكونيّ « في القمة » أم نعتبره بديهياً بتحديد كائن، أو جوهر، أو فكرة تُعتبر هي سبب كل شيء؟ أم أن الكونيّة هي عملية تنطلق « من الأسفل إلى الأعلى »، ومن خلالها يقوم المنطق البشري بتحديد السمات العامة التي يشترك فيها البشر والعناصر على اختلافها وتنوعها؟ لقد أطلق هيغل فكرة النوع المثالي للكون الذي يجسّد « السبب »، أو المعطى الذي يسمو على الكائنات والأشياء باسم « الكونيّ الملموس ». وهذا المصطلح يتعارض مع « الكونيّ المطلق » الذي يُبنى باستخدام المنطق الاستنتاجي في تعريف القواسم المشتركة للكائنات والأشياء. وهو أيضاً ما وضعه شوبنهاور حيّز التنفيذ في تمييزه بين الفكرة والمفهوم: وهي مفاضلة في الأصل واختلاف في الطبيعة ضمن جوهر الكونيّ نفسه. يمكن أن نستتنتج من خلال هذا العرض البسيط، أن سقراط اختار الكونية التي تأتي من الأعلى، وهي الكونية الملموسة، في حين أن كانط الذي قام بتحديد أصناف وميزات العقل الخالص اختار الكونية المطلقة التي تمت صياغتها عن طريق الاستدلال العقلي. لكن عندما نعرض هذه المفاهيم على بساط الدراسة والتحليل، يتضح أن الأمور أكثر تعقيدا مما كنا نتصور، فسقراط استنتج أن ما وضعه من أسس جاء قبل اكتشافه أن هذه الأسس لا تعدو أن تكون استقراء، كما أن كانط لديه فكرة قبلية عما يعتقد أنه نتاج لاستنتاجات وصل إليها. نحن إذاً في صميم الفكر المركب مع وجود العديد من المفارقات. غير أن هناك حقيقة بسيطة يجب أن نستقبلها بكل حكمة و نتذكرها جيدا، وهي أن الطريقة التي نلج بها إلى الكونية تكشف عن حالتنا الذهنية أثناء التفكير في هذا الأمر.
لقد تقدمت كل الأعراف الروحية (غير التوحيدية) والدينية بتفسيرما هو كونيّ. وبطريقة أو بأخرى أشارت إلى الكائن، أو الفكرة، أو الطريقة (الكونيّ الملموس)، وبسطت بشكل تمهيدي جوهر التجربة البشرية. وسواء كان المرء مؤمناً بأن الطبيعة تسكنها روح واحدة أو عدة أرواح، وأن على المرء أن يحرّر نفسه من الأنا ومن سجن العَود الأبدي من خلال قهر النفس أو أن على المرء أن يقر بوجود الواحد ويقوم بممارسة الشعائر، يفترض ضمنياً ، أن الحقائق والاحتياجات الأخلاقية والشعائرية تُعتبر قيماً كونيّة. فالحقيقة ، كقيمة ذات مغزى قائمة بذاتها هي منطقياً ذات مغزى (للجميع) أما بالنسبة للروحانيات والأديان التي تحدد منبع الكونيّة، فهذا لا يعني بالضرورة أن بناء الكونيّة من خلال استخدام المنطق ليس شرعياً، أو أن المسارين لا يمكن لهما أن يتقاربا بطريقة ما. قد يكون المنهجان غير متنافيين، لكن هذا من جديد يعتمد على الأحكام التي قد يطلقها المعنيون بعمليتي التأمل والبحث. فالأمر في الحقيقة لا يقتصر فقط على كيفية إدراك والدخول إلى فضاء الكونية، بل يعتمد بنفس القدر من الأهمية على القدرة على الإصغاء للآخر ومعرفة الأسباب التي تدفع هذا الآخر إلى تحديد الكونية الخاصة به، حتى ندرك في النهاية أن الكونية لها أشكال متنوعة: الكونيّ المتسامي، والكونيّ الملازم، والكونيّ الحميمي، ولكونيّ الروحي، والكونيّ المنطقي، وحتى الكونيّ العدمي الفارغ والذي لا معنى له. لهذا فإن قضية الكونيّة تتحدد في المقام الأول من خلال طرق ومسارات وحالات ذهنية متعددة.