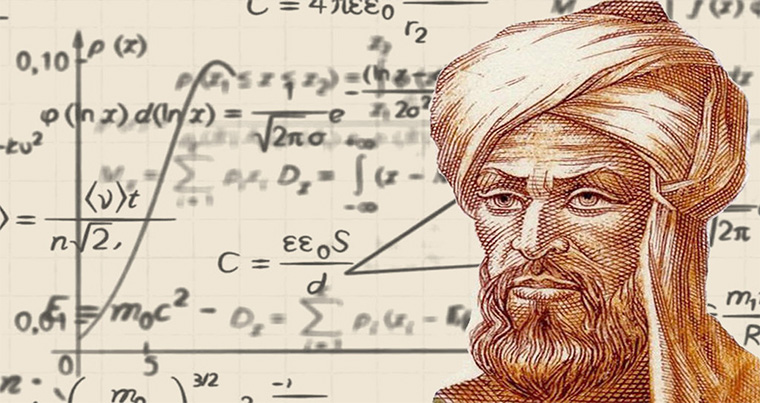كلود هنري ديبور : اسمحوا لي بالتطرق إلى نقطة أخرى ذات صلة. نحن نعاني من أشكال التعبير عن العولمة، لكن ليس للمرة الأولى في التاريخ. لقد ذكرتم أفكار ديناميكية للغاية حول أسباب العنصرية الحالية، وأود أن أذكركم أن أول أشكال العولمة ظهر في عصر الرومان، والغريب في الأمر كما يبدو للبعض أن نفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج. في روما المركزية، كان يجتمع فيها شعوب من آفاق مختلفة، جاؤوا من شمال إفريقيا، واليونان، وإسبانيا، ومن كل مكان، وأصبحوا مواطنين كاملي المواطنة. كانت توحدهم اللغة اللاتينية بشكل مبهم، التي كانت منذ القرن الأول في طور الأفول. لقد أصبنا بالذهول جراء بعض شهادات ذلك العصر، حول عدوانية العنصرية ومعاداة الأجنبي التي كان يمارسها الرومان الأصليون في حق المواطنين الذين يعتبرونهم من الدرجة الثانية، رغم أنهم أعضاء لهم حقوقهم كما جاء في ميثاق روما العظيم. ألا تعتقدون أن هناك رابط محتمل بين العولمة وبعض أنماط ردود الأفعال؟
إدغار موران : هناك فرق كبير. إن إصدار مرسوم كركلا أو دستور الأنطونية سنة 212 كان يعطي الحق للمواطنة الرومانية لجميع سكان الإمبراطورية، حيث كان يعيش البربر والإسبان متحدين وفي إطار نفس الانتماء، كما كان بعض الأباطرة من أصول أجنبية. لقد تمكنت روما من حل المشكلة على شاكلتها. لكن اليوم، لا توجد مؤسسة تعطي المواطنة العالمية في ظل العولمة الحالية.
طارق رمضان: لكن هناك حقيقة ملموسة تتجلى في كون خصوصية العولمة تؤدي إلى إنتاج ردود أفعال عاطفية، و غير عقلانية في بعض الأحيان، خاصة عندما تنفصل عن مبدأ الوحدة الذي يربطها. فعندما تقولون أن فرنسا واحدة ومتعددة ثقافيا، الكثير يخشى أن تنتهي هذه التعددية الثقافية باختزال معنى وحدة الجمهورية. قلتم كذلك أن روما منحت حق المواطنة للجميع، فيما يتعلق بفرنسا، ينبغي أن أضيف أمرين أساسيين. أولا، أؤكد ما قلتم بصدد أن فرنسا يجب أن تدمج حاضرها وماضيها في مستقبلها، هذه نقطة مهمة وجوهرية. لكن بالنسبة للأمر الثاني فالوضعية القانونية لا تحل اليوم جميع المشاكل. فكونك مواطنا لا يعكس شيئا على مستوى الشعور بالانتماء. لقد قلتم عندما ذكرتم تجربتكم الخاصة: » لقد أحسست بانتمائي إلى فرنسا، بفضل المدرسة التي كانت تهتم بنا وتدرسنا أشياء نحبها ». إن الشعور بالانتماء هو الذي يفضي إلى المصالحة، ويجسد وحدة الإنسان، وليس جواز السفر.
لقد عشت نوعا من المصالحة الجزئية، لأنني تأثرت بشكل كبير بالأدب الفرنسي وبالفلسفة الغربية. لقد شكلت هذه الفضاءات ثقافتي الفرنسية والغربية، رغم أن العديد كان يضعني أحيانا خارج هذا الفضاء الثقافي. فبالنسبة للكثير من المواطنين الفرنسيين والأوروبيين والغربيين، نحن نملك الآن وضعية جديدة غير رسمية وهي وضعية المواطنين الأجانب. فنحن مواطنون بالأوراق، لكننا أجانب عند كشف هوياتنا، ونظرتنا للآخر. هذه الوضعية التي نعيشها لها تداعيات خطيرة، فمن المحتمل أن تفضي إلى توترات وانفعالات وردود أفعال هستيرية، لأننا لم نتمكن من تحديد طبيعة المشكل وأصل المخاوف. إنهم فرنسيون أو أوروبيون بالتأكيد، لكنهم ما زالوا يشعرون أنهم أجانب، كما يعتبرهم الآخرون أنهم مُسْتَعْمِرون ويرغبون في استبدالهم تدريجيا. إنهم مشابهون لهم لكنهم مختلفون عنهم، كما أنهم يمثلون » الآخر » ويشكلون خطرا مزدوجا في الواقع في نظر الآخرين. إن اليمين المتطرف وأنصار الشعبوية يشحنون الناس بهذه التصورات، وبخطابات إقصاء هؤلاء الفرنسيين ونبذهم باعتبارهم آخرين…
إدغار موران: إنه اعتداء على الهوية الفرنسية.
طارق رمضان: تماما. التاريخ يعيد نفسه من روما القديمة إلى الديمقراطية الأثينية، وصولا إلى المجتمعات المعاصرة. لقد واجهت هذا المشكل في ماليزيا، وفي الهند كذلك، حيث ينظرون إلى الصينيين كأجانب. إن جواز السفر لا يعطيك الشعور بالانتماء، وحتى الانتماء القانوني إلى دولة ما لا يعكس هوية متعاطفة معها. إن الإطار القانوني وما تتيحه العلمانية شكليا ليس كافيا. كما أن التخفي وتسمية أبناء المسلمين بأسماء فرنسية قصد عدم لفت الانتباه، كما اقترحت مارين لوبين أمور غير مجدية. إن الحل يكمن في التربية والتعليم، فالمدرسة هي التي تعلمنا تاريخ الوطن والتاريخ المشترك، كما أن المدرسة هي التي نكتشف فيها هوياتنا، وتنمي فينا الشعور بالانتماء. لقد دعوت منذ سنوات الثمانينيات إلى الانفتاح، وإدماج الخصوصيات عن طريق المدرسة. لكن المدرسة اليوم أصبحت إقصائية، وأدت إلى إقصاء الذاكرة المشتركة.
كلود هنري ديبور : ما هي الوساطة التي يجب أن نبحث عنها أو نتبناها إذا فشلت المؤسسات من جهة، ولم يتمكن التعليم من تأسيس آليات جديدة لنقل المعارف، من جهة أخرى ؟
إدغار موران: نحن نعيش أزمة حقيقية وجذرية فيما يخص مسألة التربية، التي تعتبر من أكبر مشاكل العصر. لقد فقدت المدرسة بريقها وإشعاعها، وأصبحنا نشهد البيروقراطية، وتراجع الانضباط عند المدرسين. لحسن الحظ، لا يمكن تعميم هذه الملاحظة على الجميع. إضافة إلى أن المدارس التي توجد بالأحياء والضواحي تفتقد إلى القدرة على الإنصات للتلاميذ، باستثناء بعض الحالات التي تَفَوَّق فيها مجموعة من التلاميذ نتيجة الإصغاء إليهم. أذكر على سبيل المثال الكاتب والمدرس فرانسوا بون. لقد بدأ في طريقة تدريسه بذكر الأدباء السورياليين مثل جان جيني، والتمرد والثوار، وبعد ذلك تطرق إلى الأدباء المناصرين للتيار الإنساني، مثل فيكتور هوجو. لقد كسب جيدا ثقة تلامذته، لأنه استوعب شعورهم بالإحباط والتمرد.
نحن نعيش كذلك أزمة عميقة على مستوى التعليم. فهو يعتبر إشكالية حقيقية ، لأننا لم نعد ندرس المشاكل الكبرى التي تعترضنا. لم نعد ندرس ما يمكن أن تنطوي عليه المعارف من أخطاء وأوهام خادعة. كما لم نعد ندرس من نحن، وماهي العولمة التي أصبحنا تحت سلطتها، وكيف نفهم الآخرين، وكيف نواجه المجهول. نحن بالتأكيد ندرس الأخلاق، لكن يبقى ذلك مجرد كلام، دون أن ترقى هذه الأخلاق إلى ممارسات ملموسة في الواقع.