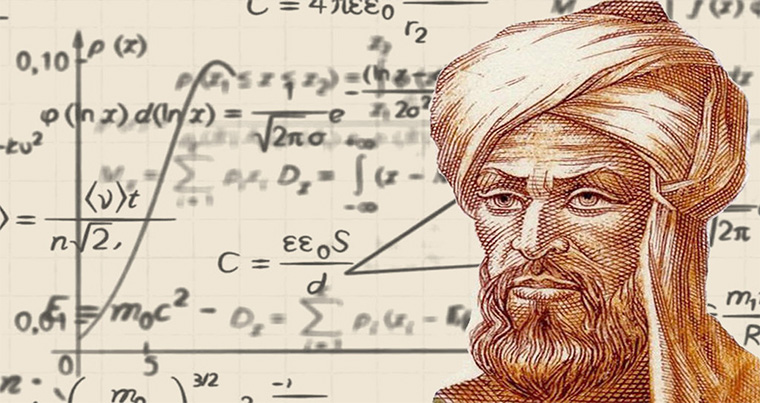لا ريب أننا نعيش في زمن صعب، فالعولمة ماضيةٌ في تغيير معالم حياتنا القديمة، والتعددية بدأت تحتل حيزاً يكبر ويزداد يوماً بعد يوم في مجتمعاتنا. وليس لنا الخيار: فمع الهجرات المستمرة، وحاجاتنا الاقتصادية، وتنوعنا الثقافي، لا بد لنا أن نواجه التحديات الجديدة وأن نتجاوب ضمن نفس السياق مع الأسئلة الفلسفية والدينية الجديدة. ولا يمكننا تجنب هذه الأسئلة بمناقشة الأبعاد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية لمجتمعاتنا التعددية بشكل فوري ومباشر. وفي الحقيقة فإننا من خلال تتبع هذه الأسئلة والطروحات التي غالباً ما تختبر في طيّاتها موضوع التنوّع، فإنه يجدر بنا أن نطرح فكرة « التنوع الخارق » على بساط البحث: إذ ليس من الضروري أن نلاحظ وأن نعترف بحقيقة التنوع البشري فحسب، بل من المهم أيضاً أن نصر على هذا التنوع باعتباره بعداً إيجابياً أساسياً من كياننا، وهو شرط من شروط عافيتنا واطمئناننا للمستقبل. إن الأمر متعلق إلى حد بعيد بالتنوع الذي نجده في حياتنا الشخصية، وفي حلقاتنا الاجتماعية والفلسفية والدينية والثقافية وحتى السياسية الخاصة، وحتى بتعاملاتنا مع العالم الخارجي. لهذا السبب فإن التنوع- الخارق لزمننا هذا يحتاج إلى طريقة خاصة وحميمة في تعاملنا مع معتقداتنا وقناعاتنا الخاصة وفي نظرتنا « للآخر ». لا يوجد تنوع في الخارج لا يرافقه الإحساس بالتنوع من الداخل. ونحن نحاول أن نقتفي أثر ذلك الطريق الذي ينبع من الخاص ليصل إلى العام، ومن الفلسفة إلى علم الاجتماع والعلوم السياسية. إنها رحلة، وهو أسلوب في طرح الأسئلة الجوهرية والمضي قدماً للخروج برؤية محتملة.
عن التنوع
في عصر العولمة والحداثة، طُرحت قضايا التنوّع والتعددية على بساط البحث والنقاش بشكل غير مسبوق، مع أننا نبدو منغلقين داخل خصوصياتنا واختلافاتنا أكثر من أي وقت مضى. إن العالم الكونيّ ما هو إلا قرية، هذا ما يقولونه، لكن هذه القرية مأهولة بسكان غافلين، سكان يتجاهلون هويتهم الخاصة بقدر ما يتجاهلون هوية جيرانهم. وبدل الاحتفاء بالثروة والغنى، أدى هذا الوضع إلى صراعات خجولة مخيفة كامنة: إنه « صراع الجهل » ، كما يسميه ادوارد سعيد؛ والذي أظنه أنا صراع التصورات. إن مفهوم التصور أكثر إثارة من مفهوم الجهل: فالجهل في الحقيقة يمكن أن ينتج عن التصور، لكن التصور يعبّر عن علاقة المرء بنفسه وبالآخرين، وهو شيء لا يتعلق بالضرورة بالمعرفة وحدها، إذ يشمل المشاعر والأحاسيس والقناعات؛ أي بكلمة أخرى هو يشمل علم النفس. إننا نفتقر للثقة، الثقة بأنفسنا، وبالآخرين، الثقة بالله و/ أو بالبشر، والثقة بالمستقبل. ونتيجة لذلك يغزو الخوف والشك والريبة قلوبنا وعقولنا دون اكتراث منا – ويصبح « الآخر » مرآتنا السلبية التي تمكننا اختلافاتنا معها من التعرّف على ذاتنا، أو « تحديد » من نكون، كي نتمكن في النهاية من إيجاد بعض الطمأنينة في مواجهة انهيار المدارك (المعارف). تحوّل هذه الديناميات تفكيرنا – حسب المفهوم الباسكالي – عن أنفسنا، وعن جهلنا، عن مخاوفنا وشكوكنا وهواجسنا؛ فمجرد وجود « الآخر » يبرر ويشرح شكوكنا . إننا نغذّي إسقاطاتنا وننسى أننا نفتقر إلى الخطط (المشاريع).
لذا علينا العودة إلى بعض الحقائق الأساسية – البسيطة والعميقة – ونبدأ بطرح بعض الأسئلة الضرورية والبحث عن المعنى. علينا أن نسبر أغوار أنفسنا وأن نتقدّم بتساؤلات، ونقد بنّاء، وتعقيد معرفي. ولا يمكن تحقيق هذا إلا بوضع فرضية مبدئية للحقيقة، التي سوف تفرز تلقائياً موقفاً يتسم بالحياء الفكري والتواضع: كل واحد منا يرى العالم من نافذته/ نافذتها الخاصة. هذه النافذة ما هي إلا وجهة نظر تلوح عند الأفق، وهي إطار مقيّد بتوجهاته وحدوده، ولهذا هو فاسد نوعاً ما – كل هذا يلوّن العالم أمام عيوننا. على المرء أن يبدأ بكل تواضع بتقبّل فكرة أن ما لدينا فقط هو (وجهات نظر)، بالمعنى الحرفي للكلمة، وأننا انطلاقاً من وجهات النظر هذه نبني أفكارنا، وتصوّراتنا وخيالنا. إن الوصول إلى قناعات تمتلك النسبية الضرورية لتوقعات المرء، تعني دون شك الارتياب بكل شيء أو عدم الوثوق بشيء. بل على العكس، قد يترتب عنها ثقة خالية من الغطرسة، وفضول صحيّ خلاّق تجاه تلك النوافذ الأخرى اللامتناهية، التي ينظر منها الآخرون منها إلى الكون نفسه.
لكن وفي ظل الظروف الحالية، ليست التصورات وحدها التي تختلف، بل وصل المرء إلى مرحلة الشك في أننا جميعاً ننظر إلى الكون نفسه، وأننا جميعاً نواجه نفس الأسئلة، وأننا كلنا نجسد ونتشارك في الإنسانية. إن الحياة في « القرية العالمية »،التي أصبحت الفردية أبرز مميزاتها، قادتنا إلى الشك ببقاء آثار من الفلسفة خلف حسابات نزعتنا إلى السلطة واهتماماتنا الشخصية. ماذا يمكن للأنا أن تستخلص من الأنانية وحب الذات؟ وكما تقدم ذكره فإن هذه هي النقطة التي يجب على الأنا أن يبدأ بطرح الأسئلة على نفسه، ومن خلال التوتر الحميم والمواجهة مع الكون المحيط، يفهم أن التنوع ليس مجرد حقيقة بل هو ضرورة، إنه أفق، وهو أمل. علينا أن نشتغل على تغيير طريقتنا في النظر إلى الأشياء، وعندها فقط ومن خلال وجهة نظرنا الواثقة، نضع في الاعتبار تصوّر الآخر ونبدأ باختبار التواضع والتعاطف الفكري والشعور بالمسؤولية. يمزج التنوع الخارق بين إدراك التنوع البشري الضروري وبين الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية.
وهنا أرى مسارين بديلين يلوحان في الأفق: الأول هو أن نختار التنقل من نافذة إلى أخرى، من فلسفة إلى أخرى، ومن دين إلى آخر، وأن نجرّب كل واحد منها على حدة، كي نفهم التقاليد والمدارس المتعددة بتعاليمها ومبادئها، التقاليد والمدارس التي تحرّك الأفراد الذين نتشارك وإياهم حيّز الحياة. من واحد إلى آخر، ومن ذات إلى أخرى يجد المرء نفسه وهو يضع يده على بعض أوجه التشابه، وبعض النقاط والقيم المشتركة. أما المسار الثاني فهو الدرب الذي يأخذنا إلى قلب المشهد المشترك الموجود أمامنا وبالتالي يدعونا إلى تقليب أبصارنا باتجاه النوافذ المحيطة. وهنا لا تكون الفكرة في التركيز على تعددية الناظرين، بل على الخوض في الشيء المشترك الذي يُنظر إليه، والتمسك بتنوّع وجهات النظر من خلال جوهر التشابه بينها. بمجرد تقبلنا لفكرة أن وجهة نظرنا هي نافذة ملوّنة تطل على الحقيقة الواسعة المشتركة، عندها علينا أن نسافر وأن ننطلق بحرّية وأن نغوص في المحيط، وأن نبحر، نتوقف، ننكفئ، نقاوم، وأن نبحر من جديد ونتذكر أنه لا وجود للمحيط دون وجود شطآنه المتعددة، وأنه ليس أمامنا سوى فرصة البقاء على قيد الحياة. اخترت في هذه المقالة أن أركّز على ما هو مشترك كي ألمس، بثقة وتواضع، المياه المشتركة التي يحدّق إليها عدد هائل من الناظرين. إن التعامل مع موضوع التنوّع يتطلب تطوير فلسفة، وعقلية هما عبارة عن انغماس في الأهداف التي تسمح لنا بالوصول إلى المواضيع، والبشر بتقاليدهم، وأديانهم، وفلسفتهم، وجمالياتهم، و/ أو نفسياتهم. المرء بحاجة لأن يضع في الحسبان بعض المفاهيم والأفكار والمثل المشتركة، والغوص فيها كي يعرف رأي الفلسفات والأديان المختلفة فيها. هذه أفضل طريقة للعودة إلى الذات.
دعونا نبدأ بالتفكير بالتوتر الواضح بين الكونيّة والتنوّع. ستساعدنا هذه الخطوة الأولى على البدء بفهم ما هو مشترك، وما هو خصوصي، والطريقة التي يستطيع بها المرء استخدام التنوّع كأفضل طريقة توصله إلى جوهر الكونيّة.
يتبع…