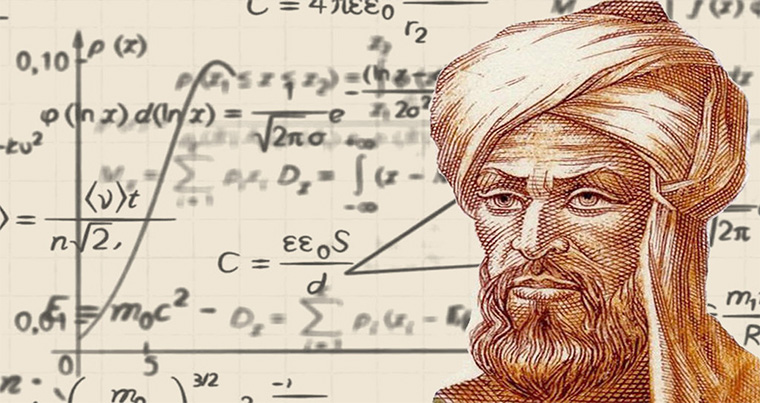عبد الهادي الشيخ صالح
قد يلاحظ أي إنسان ذو قلب ولبٍّ يعيش في هذا العقد من الزمن، تلك الأزمات المترامية والفتن المتطايرة كقطع من الليل المظلم في أرجاء شتى من سطح هذه المعمورة، نعم.. !! ومن ظنّ يوما أنّ ما شهده العالم من حروب و فتن « عالمية » في أزمنة ماضية، قد تستتبعها يوما ما أخرى، لا تقل عنها فتكا ولا دمارا؟ كيف وصلت وتيرة نسيان الانسان للألم إلى هذه الدرجة !؟ أم أن هنالك سقفًا علويًّا لمخلفات تلك الحروب قد لا ينبري ولا يرعوي ما لم يبلغه ويدرك فتكه وخطورته !؟ أو لربما اختار حالة الأزمة « حالة صحيّة » هي نَفَسُ عيشه وشرايين جسده وروح سياسته، ذلك لأنه اعتبر حالة الاستقرار حالة استثنائية عابرة قد لا تساعده على ضبط المصالح وبلوغ المقاصد؟ هل لجوء الإنسان لمبدأ الصراع لضيق أو قِصرٍ في فسحة التسامح والتفاهم المشترك أم أن هنالك أسبابا أخرى لذلك، تَحُول بين الإنسان وإنسانيته حينما يتعلق الأمر بالمصالح؟ لربما أنه جَهِلَ في النهاية أنه قد يحقق بحوار الحضارات نفس الأهداف التي طرق بابها بصراع الحضارات لكن ضمن سياق يليق بإنسانيته بشكل أساسي؟ كثيرة هي تلك الأسئلة التي تترك ذا العقل حائرا وذا القلب واللب منبهرا… تختلط عليه الرؤى وتضطرب عنده بوصلة التّصورات وتشتبك بين ناظريه الأسباب والمسببات.
سيحاول المقال سرد بعض المفاهيم في سياق ظواهر الفتن والصراع الحضاري المنتشر هنا وهنالك، من خلال بسط لبعض الفلسفات وطرح لرؤية بهدف الاشارة إليها والتوقف عندها للاستفادة والاستلهام بنيّة فهمٍ واستبصار، ونداء إلى طاولة المناقشة والبناء والنقد.
عرض « المفكر » فوكوياما في التسعينيات كتابه الذي طرح فيه فلسفته وفكرته عن نهاية التاريخ والإنسان الأخير، والذي اجتهد أن يقدم تصنيفا لبعض الدول التى رآى أنها تعيش في مرحلة ما باعد التاريخ وأخرى لا تزال تتخبط في حبائل التاريخ المتشابكة تصارع جاهدة الخلاص منه واللحاق بأخواتها. تلاه هينتنجتونغ حينما نشر كتابه من بعده بسنوات حول صراع الحضارات، واللذان أحدثا ضجة كبيرة انتقدهم البعض وساندهما واستند إليهما آخرون، كما نسج من فلسفتهما واقعا عمليا البعض من السّاسة والمفكرين، و غيرهم ممن تبصّر أنهما تزرعان سياقا خصبا ومنظومة فكرية مرجعية لتبرير سياساتهم وتجسيد أفكارهم.
لم يكن الهدف من الاشارة للنظريتين التعريف بهما أو تسليط الضوء عليهما ولكن فقط لسببين، أولهما تقديما للموضوع ثانيهما الإشارة إلى بعض الأسئلة المحورية، تتعلق بسبية امتلاك المرء/ المفكر لمثل هذه الأفكار الاختزالية المشوّهة للرؤية الكونية والمعطى الإنساني المشترك بشكل عام. وكذا عن الحالة الذهنية وما للخلفية التاريخية، الفلسفية، التربوية والعقدية من تأثير على الانسان من خلال اصطباغ افكاره ورسم نمط تفكيره ورؤيته للأمور.
جاء من بعدهما نموذج من المهم جدا أن نعرج إليه بعد سرد النظريتين في نفس السياق (صراع الحضارات ورؤية المشتركة الإنسانية)، فقط على سبيل المثال لا الحصر، بنظرة تفحصية استفسارية غير دوغماتية ولا إيديولوجية. وهو الرئيس والمفكر الراحل علي عزت بيجوفيتش حينما تكلم عن فلسفة « المدينة/الجسر »، ذلك لأن بلد البوسنة والهرسك جمع عدة أطياف مختلفة في حيز مكاني واحد، وقد مرُّوا باختبارا عصيب ممحّص، وبثنائية سامّة قاتلة، قطعَتْ أنفاسهم وأفقدتهم إنسانيتهم ليختاروا إحداهما، ولكن مع ذلك كان الصبر حليفهم تحت راية واحدة، وراء رئيس أمين وهي حماية لحمة الوطن مهما كانت الاعتبارات، وقد رسم علي عزت لهذه الثنائية صورة إدراكية موضحة حينما يقول أنها كانت تماما كمثل الاختيار بين سرطان الدم أو سرطان الدماغ وكلاهما قاتل في النهاية. نقرأ له في سيرته الذاتية يقول: » إن محادثاتنا في البوسنة والهرسك، تجري في سياق برنامج يطلق عليه اسم الجسر، ونشعر أن هذا هو الاسم المناسب لهذا البرنامج. لأن البوسنة والهرسك تحتل مكانة فريدة. إنها جسر بين الحضارات والثقافات والأديان. فقريبا من المكان الذي نقف فيه الآن توجد الكنيسة الصربية الأرثدوكسية، وهناك معبد يهودي قريب من النهر، والكاتدرائية تقع على بعد أقل من 100م إلى الشرق، وعلى بعد 200 متر منها يوجد المسجد الرئيسي. وهكذا في نصف قطر مقداره أقل من 200 متر نستطيع رؤية الدور الرمزي لمعالم البوسنة والهرسك بوصفها مكانا لالتقاء الحضارات. وبمواجهة هذه الصورة، نتساءل فيما إذا كان أجدادنا أعقل وأفضل منا، فمن خلال هذه اللحمة النسيجية المتداخلة، تمكنت حضارات الماضي العظيمة من تحقيق مستوى رفيع من التفاهم المتبادل. وعلى العكس، فإن بإمكان الحضارة إيجاد جذور عامة مشتركة، ومعرفة وقيم عامة مشتركة، تفوق الفروق والاختلافات التي بينها. إن البوسنة والهرسك تمثل المكان الذي جرى فيه اختبار هذه الاحتمالية بكل مخاطرها، وبدلا من كونها موقع نزاع فإن بإمكان البوسنة والهرسك أن تكون مكانا يمكن أن يتم فيه بناء مجتمع وينتصر فيه التسامح والاحترام المتبادل » .
نلاحظ جليا أن المفكر علي عزت يرى من نظرة مختلفة تماما وبعيدة كل البعد عن نظرتي هنتجتون وفوكوياما، إذ أنه يرى أن الأساس الذي يشرّف حضارات الجنس البشري « المكرّم »، تحقيق التسامح والتفاهم وإيجاد معرفة وقيمٍ وجذور عامّة مشتركة، تسمو على كل الفروق والاختلافات. كيف لا وهو الذي أفنى حياته في سبيل رسالة التسامح. وهنا نطرح اشكالية قد تبدو يقينية أنه كما أن لفلسفتي فوكوياما وهنتنجتون آثارا جليّة ومباشرة على الواقع الحياتي، فكذلك لهذه الرؤية أيضا آثارا ونتائجا تصطبغ بها ومنها، إذا ما جسِّدت واقعا حياتيا وإذا ما وجدت أمناء يؤتمنون عليها تتوافق خلفياتهم وفحوى أفكارهم مع قيم التفاهم والتسامح.
لكن فقط في النهاية لو ننتقل إلى المقياس الفردي لكل إنسان يعيش وسط وضمن النسيج الإنساني داخل هذه المنظومة الكونية، فليس هنالك وسيلة أفضل من إعاقة الفعل الحاضر والحد من تأثير الفعل الذاتي الشخصي المسؤول، كتكبير مقاييس الرؤية واستحضار المعطى العالمي أمام معطيات الإسهام الشخصي، ولكن نعلم جليا أن ربنا عز وجل لا يكلف نفسا إلى وسعها، فرهان الإنسان ومحور اهتمامه واسهامه يتمركز أساسا على دائرة الوسع المرتبطة بما سخر له الله من إمكانات مادية وفكرية ومعرفية…. بدءا من الدائرة العائلية والمحيط الضيق، من المدرسة والقسم، إلى أبعد حدود وسعه. فقط يجب علينا أن ننتبه إلى وتيرة جهدنا وهل بلغنا الوسع ونقدم الواجب، أم أن هنالك تقصيرا وتكاسل. وأن نسأل أنفسنا أيضا كيف هي رؤيتنا لبعضنا البعض، على ضوء كل الاختلاف الذي نعيشه داخل أوطاننا من أديان أو معتقدات أو شعائر؟ كم من مدينة تعتبر جسرا بين عدة حضارات متفاهمة تعيش واقعا مشتركا، تحاول إيجاد قيم ومعرفة مشتركة وما هو اسهمنا نحن في هذا النسق..؟ المدينة الجسر تنشأ أساسا من أناس فهمواواستوعبوا المعنى، إنطلقوا بنية اسهام وعمل فعال ليحصدوا في النهاية نتيجة مشتركة وواقعا أسمى.