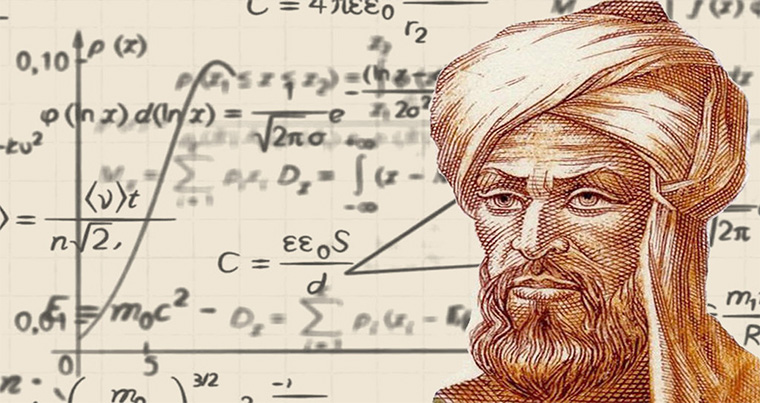لم يسبق الحديث عن الإسلام بهذا الحجم إلا في السنوات الأخيرة. لقد أصبح الإسلام هو موضوع الساعة سواء في وسائل الإعلام أو في الجامعات، لدى العديد من الفعالين السياسيين والاجتماعيين ، كما أصبح موضوع النقاشات المحتدمة المجانبة للصواب، والحاملة للكثير من المغالطات. تحتل إذن قضية الإسلام مكانة كبيرة، كما لو كان هناك مشكل حقيقي مع الإسلام، ليس للحديث عنه بشكل إيجابي، بل للحديث عنه كخطر حقيقي، وكمصدر للمخاوف و الإقصاء. من جانبنا، نقف شبه عاجزين أمام هذه الظاهرة الجديدة، ولا نعرف جيدا كيف يجب أن نتصرف، هل نتصرف بعدوانية أم بالانزواء، وقد انتهى الأمر بجعل المسلمين ومجتمعاتهم كموضوع جديد للدراسة يتدارسونه من جميع الجوانب. وهذا ما نراه في العديد من المقالات الصحفية، والمؤلفات التي تحاول دراسة الظاهرة ورصدها وتفسيرها، من خلال الإحاطة بالأبعاد المتعددة للظاهرة التي تتجلى في الدين، والعلمانية، والغيتوهات، والطائفية، والإسلام السياسي، والتطرف، وقضية المرأة، والهجرة، والجنوح أو الإجرام، وشرور الإنسان، وأمراض الروح، والآمال في بعض الأحيان. تنجز هذه الدراسات في غالب الأحيان دون تبصر و تدقيق في الأمور، فننتهي بخلاصات تنعت قضية الإسلام والمسلمين بالإشكالية. أما نحن، فإننا نشاهد بكل غضب وسخط هذه المسرحية الحزينة، حيث ينكرون ديننا ويقومون ببتره، واختزاله إلى الأشكال الكاريكاتورية الأكثر سوقية وسخافة. إن العقدة تزداد اضطرادا عندما نستشعر أننا مستهدفون بهذا الميز العنصري، إنه أمر خطير للغاية.
أن نكون شهداء
لا يجب أن نندهش عندما يتكلم الآخرون في مكاننا عندما نبقى صامتين. قد يتكلمون عنا بخير أم بسوء، لكن في غالب الأحيان، يتحدثون عنا بسوء. إن الأحداث الأخيرة التي شهدتها الساحة الدولية، وقضية الحجاب والمساجد، والبلبلة التي تعرفها الضواحي الفرنسية، وصعود الراديكالية هي المواضيع الأساسية التي تبقى موضع الأبحاث والخطابات السياسية في الظرف الراهن. ماذا يمكن أن نتوقع من الآخر إلا هذه النظرة الاختزالية للإنسان المسلم، الذي أصبح مرادفا للعنصر الإشكالية، أو العنصر المتطفل على الحركية الاجتماعية والسياسية للمجتمعات الغربية. هناك ضغوط كبيرة على المسلمين، يقابلها انزواء وانغلاق شبه طبيعي. تتضاعف العقدة إذن بهذا الشعور بالانطواء على الذات.
وعندما نعي خطورة هذا المسلسل، فنحن نكون أمام خيارات تلزمنا أن نتحمل مسؤولياتنا. فإما أن نبقى منغلقين، بحكم أنه تصرف طبيعي ومشروع مادام الغرب يشن عدوانه كل يوم على الإسلام والمسلمين، وإما نتخذ قرار مقاومة هذه المحاولات عبر اتخاذ موقف مغاير. فأمام هذا النبذ، والعنصرية، ومعاداة الإسلام، والإهانات المتكررة، وعندما يدفعنا الجميع إلى الانغلاق والانزواء، يجب آنذاك أن نسلك مسارا مغايرا تماما نلتزم من خلاله بالانفتاح على الآخر، ومحاورته، والحديث معه. من واجبنا إذن أن نتحمل مسؤولياتنا، ونساهم بخطابنا وحضورنا في صناعة التاريخ بكل فاعلية. إن الحضور للنقاشات العديدة التي نكون فيها مستهدفين، وقضاء معظم أوقاتنا في الرد على كلام المحاورين، والشعور بواجب تبرير سلوكياتنا مع إظهار حسن النية لنكون مقبولين عند الآخر، هذه الأمور ليست هي الحل. لا يمكن أن نعيش السكينة والتوازن الذاتي إذا كنا دائما نعتقد أننا في محاكمات لا تنتهي. إن هذا المسار ليس له مخرج. إن بعض المسلمين يرتكبون هذا الخطأ حتى يثبتوا اعتدالهم وتحضرهم، فينحنون أمام جميع المطالب، ويستجيبون إلى كل ما يفرضه عليهم الآخرون. إنهم سيكونون بهذا السلوك، مسلمين عبر الوكالة، منسلخين من أنفسهم، كل هذا ليحظوا بالقبول عند الآخر الذي يريد أن يصنعهم كما يريد هو (المقصود هنا بالآخر هو الغرب)، لا كما يريد المسلمون أنفسهم… إنها تعددية بشكل غريب، لا تعدو أن تكون دعوة من الغرب إلى الامتثال إلى النمط الغربي الوحيد.
اليوم يجب أن نفرض وجودنا من أجل التبليغ والشهادة على العالمين. أن نكون يعني أن نجد أفضل تعبير لتوازننا الداخلي. يعني كذلك أن نعيش بامتثال أوامر الله، وبعملنا على تطهير قلوبنا، وبالالتزام بقضايا العدالة والتضامن. إن الشهادة تقتضي صياغة خطاب واضح، واتباع خيار معين عن وعي، بعيدا عن مختلف الضغوطات المحيطة، و بعيدا عن المواضيع والأسئلة التي نريد أن نتطرق إليها، والثروات التي نريد أن نتقاسمها مع الآخرين. إذن الهدف الأساسي في نهاية المطاف الذي يجب أن تحققه الأجيال الشابة والقديمة هو أن نغذي في أنفسنا الوعي بثرواتنا ومسؤوليتنا في المشاركة والإسهام في المجتمع ببساطة وعمق. إذن إذا تمكنا من الولوج إلى هذه الحالة الذهنية وهذا الوضوح فإننا نكون قد تجاوزنا اختبار الخوف و الوجل .إنها مرحلة أساسية، وممر لابد من اجتيازه.