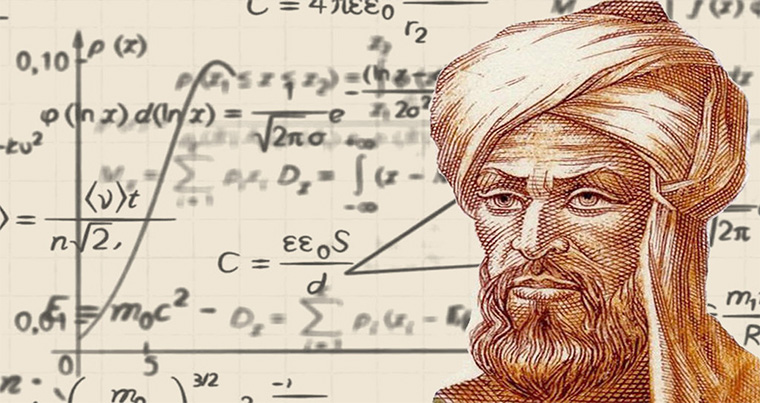لقد تطرقنا حتى الآن إلى توضيح بعض المفاهيم ذات أهمية قصوى، دون أن نقصد أن المفاهيم الأخرى تبقى ثانوية، بل على العكس من ذلك. سنتطرق في خاتمة الجزء الأول، إلى بعض المواضيع كالمحبة، والمعرفة، اللتان تلزمان الإنسان أن يعيش في محيطه دون انغلاق أو تقوقع على الذات، بل هذه هي الخلاصة الوحيدة الممكنة، لأن المفاهيم الأخرى التي قمنا بتوضيحها آنفا لها غاية واضحة وهي وضع القدمين على الطريق والسلوك إلى الله تعالى لتحقيق القرب منه. أما المحبة والمعرفة فغايتهما هما عبادة الله وخدمة الناس كذلك.
إن المحبة مفهوم مركزي لا يمكن التغاضي عنه أو فصله عن جوهر الدين، رغم أن بعض المسلمين يميلون إلى تجاهل التعبير عن هذا الحب. قال تعالى : » قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ « . لا يمكن إذن استيعاب جوهر الإسلام دون التطرق إلى الحب، فكل ما بني عليه الإسلام لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال العلاقة القلبية التي تربط الإنسان بخالقه.
لقد خلق الله تعالى الجنة والنار كنوع من الجزاء. لكن هناك نظرة أخرى تسمو على هذه الأخيرة، تحدث عنها بعض المفكرين و بعض المتصوفة المسلمين، منهم الإمام النووي (1233 ، 1277) الذين قال : » للعبادة مقامان : مقام التاجر الذي يعبد الله تعالى من أجل ما عند الله، ومقام المقرب الذي نذر حياته من أجل تحقيق محبة الله تعالى ». إذن يختفي هنا مفهوم التجارة ليحل محله مفهوم المحبة الكاملة والمطلقة وبدون مقابل.
تزداد هذه المحبة وتتقوى بالتزام الأدب مع الخالق تعالى، وبالصرامة القوية مع الذات. هذا هو معنى المؤمن والرباني، الذي يسلك طريقا تتطلب تحمل المشاق من أجل التحرر من كل ما سوى الله، وبلوغ مقام السمو وتحقيق القرب من الأعلى سبحانه وتعالى. هذه هي الغاية القصوى التي يرجو كل مسلم بلوغها، فهي لا تبلغنا إلى مقام الخلاص الفردي فحسب، بل تبلغنا مقام المحبة المطلقة للذات الإلهية.
يجدر بنا كذلك أن نوضح ما نقصده بالتزكية. لقد ذكر الإمام الغزالي (1111-1058)في كتاب إحياء علوم الدين فكرة جديرة بالأهمية، حيث قال أن القلب يكون دائما محتويا لشيء ما، لأنه لا يمكن أن يكون فارغا بشكل كامل. إذن للإنسان الخيار أن يملأ قلبه بالتفاهات، كما له الخيار أن يملأه بكل ما هو أساسي وجوهري وكل ما له صلة بالله تعالى. تتطلب منا التزكية إذن تخلية القلب من التفاهات وتحليته بالأمور الجوهرية. وهكذا يكمن معنى الحياة في نهاية المطاف في الوعي بما هو أساسي في وجودنا، وهنا نجد التذكير بهذا البعد في الحديث النبوي الشريف : » أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، فإنه يراك ». يعني أن نتصرف في حياتنا كأن الله يرانا، وليس المقصود هنا أن نشعر بالذنب، بل أن نستحضر دائما رقابة الله تعالى، لنبلغ مقام الخشوع. وليس المقصود بالخشوع هو خشية الله تعالى، كما جاء في بعض نسخ القرآن المترجمة إلى الفرنسية، وهذا ليس صحيحا لأن الخشية يمكن أن نلخصها في الخوف. إن مصطلح الخشية يمكن أن يكون تعبيرا عن الخوف من شيء ما، كالخوف من المستقبل مثلا، كما يمكن أن يعكس الشعور بالذنب الذي يسكن المسلم الواعي أن الله يراقبه وأنه على علم بأخطائه وهفواته.
لكن المعنى الأكثر دلالة للخشية هي التي تكون نتيجة المحبة العميقة للمحبوب، والقرب منه إلى درجة أننا نخشى أن نخيب ظن المحبوب فينا. نجد هذا الشعور في العلاقة بين رجل وامرأة يتقاسمان مشاعر الحب، أو عند الطفل الذي يحب والديه ويخشى أن يخيب ظنهما. إنها خشية ناتجة عن احتمال عدم الاستجابة لانتظارات المحبوب الكريم. إذن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار هذا التعريف الأخير، حتى نبقى أوفياء لجوهر النصوص، يعني المقصود بالخشية هو الحب وتعظيم شأن المحبوب. يعتبر الحب وطاعة المحبوب مفهومان بالغا الأهمية في الروحانية الإسلامية، وفي جميع الروحانيات الأخرى التي تركز على مدخل الحب حتى تكون الطاعات مكتملة في جو من السلام الداخلي.
لكن القدرة على الحب تتطلب كذلك الإحاطة بأمرين إضافيين وهما : علوم الظاهر وعلوم الباطن، وهما المكونان الأساسيان لوعي المؤمن، ويتطلبان مجهودات فكرية وباطنية كبيرة. قال تعالى: » إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ « .
قال المفسرون أن المقصود من العلماء في هذه الآية، هم علماء الظاهر وعلماء الباطن على حد سواء، المهم هو أن يكون هذا العلم يكتسي طابعا نورانيا لنفهم المقصود من كلام الله عز وجل، لأن الفهم عن الله لا يتأتى إلا بسلوك طريقه ومعرفته ومعرفة الغاية التي من أجلها خلقنا الله عز وجل، كما لا يتأتى إلا بطاعته و تحقيق محبته. قال صلى الله عليه وسلم: « اللهم إني أسألك حبك، وحب من يحبك، و حب كل عمل يقربني إلى حبك ».
وصلنا هنا إلى عمق رسالة الإسلام، حيث يمتزج العلم والنور بالمحبة والقرب من الله عز وجل. وهذا ما يدعونا إلى التمسك بجوهر هذه الرسالة ظاهرا وباطنا لتكتمل جمالية رسالة الإسلام.