القضايا السياسية والاجتماعية والإعلام*
عندما يفتقد السياسيون إلى الأفكار أو الشجاعة اللازمة للترويج لسياسات اجتماعية، يستغلون، ببساطة، التصورات والمشاعر الشعبية، حتى ينتهي بهم الأمر إلى «ثقفنة»[**] أو «تديين» أو «أسلمة» القضايا الاجتماعية. وهكذا تتأسس صلة مباشرة أو ضمنية بين: المشكلات الاجتماعية والعنف والتهميش من جهة، وبين: لون بشرة الأفراد («العرق») أو الأصل، أو الديانة، من جهة أخرى. وإذ تعوزهم الأفكار السياسية، فهم يعمدون إلى نظريات شعبوية تلائم أغراضهم، غالبًا ما تكون عنصرية في ظاهرها أو في باطنها. وفي صلب هذه العملية يكمن خطر يتمثل في أن يتبنى المواطنون المسلمون أنفسهم هذا الخطاب، فيبدأون بالظن أنّ مشكلاتهم ليست سياسية بل دينية وثقافية. ولأنهم غالبًا ما يكونون غير ملمين باستراتيجيات وتلاعبات رسخها الزمن (علاقات قوة، وتمثيلات، وما إلى ذلك) في المعالجة العامة لقضايا العرق (مثل تلك المتصلة بالأمريكيين الأصليين، والأمريكيين الأفارقة، والعرب وغير العرب، الخ.) فهم جاهزون–بسذاجة يلامون عليها للمسارعة إلى القبول بمعادلة لن يصلوا إلى التمكين أبدًا بمقتضاها، ولأنهم أقلية من حيث الانتماء الديني والثقافي، من تجنب التهميش الاجتماعي. عندئذ يبدو إحساس الضحية مبرَّرًا، ما دام المجتمع وسياساته لا يمنحان أي أمل.
يتعيّن رفض ومواجهة مثل هذا التفكير الخطير، ولطالما كررت أن شعور الضحية أمر تجب محاربته، لكن لا يجوز أن يحُول هذا دون أن نتبين أن هناك، حقًّا، ضحايا تمييز في الوظائف وفي الإسكان وفي العدالة الأكثر عمومية في توجهها العنصري. فالعنصرية واقع حقيقي والطريقة التي يدار بها بعض المدن، أو المناطق، أو الضواحي، تذكرنا، بكل أسف، بالنماذج الاستعمارية، حيث يُدفع بعض المواطنين إلى الشعور بأنهم أقل قيمة من غيرهم، بأنهم مواطنون من الطبقة الثانية. لكن الاعتراف بوجود ضحايا شيء، واكتساب عقلية الضحية شيء آخر. أنا أدعو لموقف مغاير تمامًا: لأن هناك ضحايا، بالفعل، فيتعين على الناس أن يقاوموا غواية الشعور بأنهم ضحايا وأن يلزموا أنفسهم بالمطالبة بحقوقهم.
وهذا يبدأ بمطالبة السياسيين بالكف عن «ثقفنة» المشكلات أو «أسلمتها» لمجرد أنهم لا يعرفون كيف يحلُّونها بسياسات اجتماعية جديدة وأكثر شجاعة. فسياسيونا يفتقرون إلى الشجاعة ويسيطر عليهم هاجس الدورة الانتخابية، وهي أمر مختلف عن الزمن الأطول الذي تستغرقه الإصلاحات الاجتماعية. ومشكلات مثل البُنى الاجتماعية المفتقدة، أوالبطالة، أو الإسكان، أوالتمييز لا علاقة لها بالدين: إنها قضايا اجتماعية تحتاج سياسات اجتماعية. وليس بوسع المرء إلا أن يشعر بالارتياح، لأن غالبية الطبقة السياسية، إبان أحداث الشغب في الضواحي الفرنسية في 2005، امتنعت عن تحويل المسألة إلى مشكلة ثقافية ودينية: فقد كان يمكن أن تترتب على ذلك نتائج دراماتيكية. لكن، وبعد انقضاء أربعة أعوام-وبرغم الانتخابات الرئاسية، والتشريعية، والمحلية-لم يحدث شيء، لم يتغير شئ. ظهر التعقل في توصيف أعمال الشغب، لكن ذلك التعقل تلاه أمر سلبي، فقد بقيت الطبقة السياسية صامتة بخصوص هذه المسائل، خالقة الانطباع بأن تلك ليست مشكلات المواطنين الحقيقيين، أنها ليست مشكلات حقيقية، داخلية، ذات أولوية: كل ذلك أوحى بأن تلك المناطق الحضرية والضواحي تبدو وكأنها منبتّة الصلة ببقية البلاد. وفي الولايات المتحدة لا يجب أن ننخدع بانتخاب أول رئيس أمريكي أفريقي فنتجاهل العرقية البنيوية وما يلاقيه السود من مظالم يومية. ومثل هذه العمليات التي «تثقفن» أو «تؤسلم» المسائل الاجتماعية، أو تمضي في اتجاه معاكس فتحولها إلى ما يشبه منطقة محايدة حقوقيًّا، تمكن ملاحظتها في كل البلدان الغربية عندما تقترب الانتخابات أو في أوقات الأزمات.
وإذا أضفنا إلى ذلك قضية الهجرة، تصبح الصورة أكثر إعتامًا. فبدلًا من الحكم على الظواهر في ضوء حقوق الإنسان من ناحية، والحقائق الاقتصادية من ناحية أخرى، يجري تحويلها إلى مسائل هوية، ودين، وثقافة: فهذه الأمور لا تتعرض للتهديد من الداخل فحسب، ولكن من الخارج أيضًا، بالتدفق المتواصل للمهاجرين. ويتزايد شيوع الإشارات المغرضة، أو حتى العنصرية الصريحة في الخطاب السياسي وبين الناس: عوالم السياسة وإدارة الاقتصاد يجري التخلي عنها لتحل محلها اعتبارات ثقافية ودينية «جوهرية»[†] تتمركز حول الهُوية وتبرر كراهية الغرباء والرفض. ففي سويسرا[1]، أوالدانمرك، أو إسبانيا، أوألمانيا، أوفرنسا، أوإيطاليا، وأخيرًا في كل أنحاء أوروبا، وكذلك في الولايات المتحدة أو في كندا، أو أستراليا، لا يرمز الإسلام والمسلمون إلى مواطنين مستقرين بل إلى مهاجرين أبديين بسبيلهم إلى أن يُدمجوا أو يُشهَّر بهم. وفي أوروبا كان يتعين النظر في دمج تركيا على أساس شروط القبول، لا سواها: هل تركيا مستوفية لشروط الاندماج في الاتحاد الأوروبي، أم إنها ليست كذلك؟ فإذا كانت مستوفية يكون بوسعها الانضمام؛ وإن لم تكن، تعين عليها أن تنتظر وتحاول بلوغ هذا الهدف. ولكن ما يمكننا ملاحظته هو أن التحول يحدث هنا، مرة أخرى، باتجاه الثقافة والدين: مشكلة تركيا، كما يقال لنا صراحة أو تلميحًا، هي مسألة دينية وثقافية تهدد التوازنات الأوروبية والتجانس الثقافي للقارة. هذا ما قاله أعضاء في البرلمان الأوروبي، والحكومات تتظاهر بأنها لاتدري: لكن الرئيس الفرنسي السابق «نيكولا ساركوزي» قد صرح بأعلى صوته بما تفكر فيه الغالبية في صمت. الصورة إذن قاتمة، و تحتوي على تناقضات خطيرة.
ويمكننا أن نلاحظ، في كل مكان، زحزحة المسائل الاجتماعية والسياسية باتجاه الحقل الثقافي والديني: فالسياسيون العاجزون عن ابتكار سياسات تتصف بالعدل والمساواة، على المستويين الاجتماعي والسياسي، يبررون غياب الاتساق بل والتناقض والنفاق، في بعض الأحيان، باعتبارات عرقية، وثقافية، ودينية، يفترض أنها تبرر أو تشرح التفرقة في المعاملة. وما يتعين على المواطنين الغربيين المسلمين أن يبادروا إلى المطالبة به هو الاعتراف بوضعهم، وبضرورة أن يلزم المجتمع المساواة في المعاملات، على كل المستويات. ومن الضروري إعادة النظر في السياسات الاجتماعية، وكذلك في الإدارة اللازمة لعلاقات القوة، حيث إن هذا هو لب الموضوع بالنهاية. وتتلخص المسألة في القبول بأنّ العلاقات الاقتصادية تلزمها معالجة سياسية: فلأن المجتمعات الغربية محكومة بهاجس قضايا الهُوية، ولا تكف عن تركيز الجدل على «القيم» أو «الثقافة» أو «الحضارة» فهي تتجنب قضايا مثل سيادة القانون، والمساواة، وعلاقات السيطرة الموضوعية، والتشهير، والتهميش الاقتصادي والاجتماعي، وقضايا التمييز السياسي، والعنصرية، وكراهية الغرباء. وبذلك تستسلم هذه المجتمعات لأوجه قصور خطيرة في العملية الديمقراطية. فباسم فكرة جديدة، أُعِيدَ بناؤها، عن الهُوية، وباسم تمثيل للذات انتقائي ومؤدلج، تُظهر أعداد هائلة من المثقفين في الولايات المتحدة، أو كندا، أو أوروبا، أو أستراليا، أو نيوزيلندا، الاستعداد لخيانة بعض قيمها الديمقراطية الأساسية. وهذا الأمر يشكّل خطرًا حقيقيًّا.
لا يمكننا هنا أن نغفل عن أو نقلّل من أهمية و قيمة الدور الذي يلعبه الإعلام في التمثيلات أو في طبيعة المناظرات الوطنية والدولية. في الواقع، بوسع المرء أن يبقى سلبيًّا ويحتمل «سحر الإعلام» الذي يميل بطبيعته إلى أن يركز على الأزمات ويضخم التمثيلات الإشكالية أو السلبية؛ وبوسعه أن يفكر في ربط الصحفيين والإعلام بالديناميات العامة التي أشيرُ إليها هنا. ولا يعني هذامحاولة السيطرة على الصحفيين أو محاولة الحد من حرية التعبير والتحليل لديهم، بل يعني العمل على مسائل أساسية وطويلة المدى: أولًا، بجعل الصحفيين يدركون أنهم مواطنون ومن واجبهم أن يبقوا ضميرهم المدني منتبهًا أثناء أدائهم عملهم. وهذا يستتبع أن يركزوا على السياقات أكثر من المفردات الخبرية، وعلى جهود البناء المعمقة قبل التركيز على «الخبطات» الصحفية وعلى التغطية الإثارية الصادمة للأحداث. وهذا يحتاج «سياسات إعلامية» تركز على تدريب الصحفيين (فيما يخص القضايا الثقافية والدينية من ناحية، والمسائل الاجتماعية وعمليات التهميش من ناحية أخرى). وثانيًا، بإشراك وسائل الإعلام المحلية، وزيادة التعريف بما هو جدير بالاهتمام من الأنشطة المحلية القصيرة المدى والطويلة المدى. ونظرًا لدور الصحفيين التوفيقي الذي يستحيل تجنبه، فهم يشكلون التمثيلات وهم، بالتالي، لاعبون رئيسيون في إدارة التعددية الاجتماعية، والثقافية، والدينية، وفي إنماء الشعور بالانتماء المشترك، وكذلك في تغذية محتملة لأشكال من التوجس والخوف المرضي.
ويتعين على المواطنين وعلى كبار الناشطين الاجتماعيين والسياسيين أن ينظروا في قضايا التواصل، على نحو أكثر صرامة ومنهجية. وبعيدًا عن استراتيجيات «العلاقات العامة» واللعب على الإثارة وعلى الصورة، يتعين تشجيع الصحفيين والناشطين في مجال التوافق الاجتماعي على التمهل، على تفهم تعقيدات القضايا، وعلى إدراك الأمور في ضوء السياقات الطويلة المدى والتطور التاريخي. وهذا تحدٍّ صعب، بالحقيقة، لأن الصحفيين هم أنفسهم خاضعون لضغوط الوقت وتصورات الأغلبية. وعلى أية حال فنحن بحاجة إلى صحفيين يجرؤون على تحدي الآراء الجذابة التي تلقى قبولًا، ويضعون المسلّمات موضع التساؤل، ويطرحون الأسئلة المناسبة. أمثال هؤلاء تتزايد ندرتهم، لكنهم موجودون ومساهماتهم أساسية يجب تشجيعها.
[*] المقالة مأخوذة من كتاب What I believe للدكتور طارق رمضان الذي سيصدر بالعربية في وقتٍ قريب.
[**] في النص الأصلي culturalizing. – المترجم
[†]في النص الأصلي essentialistأي تبحث في الجوهر أو الأصل الديني أو العرقي الثابت وليس في الظرف التاريخي المتغير. -المترجم
[1]في سويسرا، طالب بعض قادة حزب «اتحاد الوسط الديمقراطي» (UDC) في أقصى اليمين، بتجريدي من جنسيتي، بدعوى أن التزامي بالإسلام واضح من عجزي عن الاندماج. بل وطالبوا بحظر بناء المآذن، لأنها ترمز إلى توطن المسلمين، وإلى «التعالي في استعمارهم» بما يناقض «الجوهر المسيحي» للثقافة السويسرية.






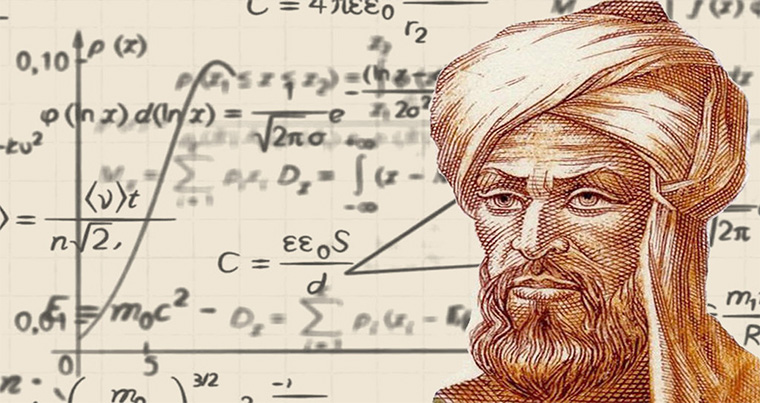




السلام عليكم د. طارق ورحمة الله وبركاته
مقالكم القيم عن دور الإعلام أراه مفيدا وهاما للإعلام الموجه للمجتمعات الغربية .. أما نحن فماذا نفعل حيال الأزمة الحادة التى تواجهها مهنة الإعلام فى مجتمعاتنا العربية التى سخرت النظم الحاكمة الإعلام فيها لتكريس سيطرتهم على الشعوب ..ماذا يفعل من فلت منهم من تلك السطوة ؟ كيف يفعل صوته ؟؟ كيف يساهم بفاعلية وسط الهراء المنتشر والهزل منقطع النظير ؟؟!!