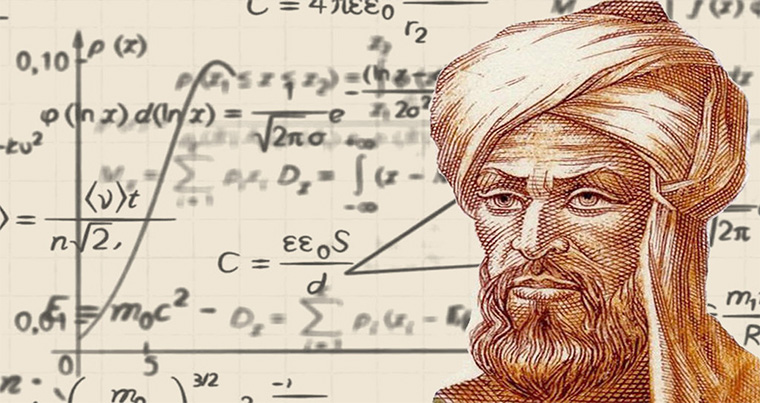رغم المكانة التي كان يجب أن تحظى بها التربية في الشريعة، نجد أن أغلب المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة تهمل التربية والتعليم بشكل مقلق. يبدو جليا أن هناك عجزا كبيرا على مستوى التعليم، بسبب تقادم المنظومات التعليمية أو غيابها في بعض الأحيان. إن المدارس العمومية في أفريقيا، والشرق الأوسط أو آسيا محكوم عليها بالفشل، ويظل مستوى التعليم ضعيفا جدا. أما القطاع الخاص الذي يتميز نسبيا بفعالية أكبر، فإنه لا يكون إلا في متناول نخبة معينة لديها ما يكفي لسد حاجيات التمدرس.
وعلى مستوى التربية الدينية، فالاختلالات عديدة كذلك. فالتعليم في هذا المجال يكتفي في أغلب الأحيان بالحفظ عن ظهر قلب. يتعلم التلاميذ التواريخ والقواعد والأوامر شكلا، لكن المضمون لا يستوعبونه. في حين نجد أن الناس يرحبون بالعدد المتزايد لحفظة القرآن الشباب، وهم على حق، ولكن لا يتهممون بما فيه الكفاية بمدى استيعاب هؤلاء الحفظة معاني القرآن والأحاديث النبوية والأوامر الدينية.
هذا التعلم عن طريق الحفظ عن ظهر قلب له أثران نراهما ينتشران عيانا : إما يترك الشباب دينهم أو يوقرونه فقط بسبب العادات والتقاليد، وإما يصبحون شكليين، يتبنون في بعض الأحيان – بشكل دوغمائي وبسبب التقليد- مواقف طائفية غير قابلة للتبديل، وهذا ما نعاينه كذلك في المجتمعات الإسلامية التي تعيش كأقليات دينية.
هذا التعليم الشكلي في غالب الأحيان لا يرافقه التدريب على التفكير النقدي إلا نادرا. يعلمون التلاميذ تعظيم النصوص والأحاديث وتوقير كبار علماء السلف، لكن بتفادي منطق التساؤل، كما لو كان التوقير يفترض غياب التساؤل. ورغم ذلك، كان الصحابة وكبار العلماء الأوائل يحثون تلامذتهم على التساؤل عن المصدر وعن أسس التأويل قبل القبول بأي رأي من الآراء الفقهية؛ وها نحن نرى المسلمين، بعد خمسة عشر قرن، يرددون النصوص دون استيعاب ويقلدون دون تساؤل.
هذا التلقين الديني غير المكتمل، والمقطوع في غالب الأحيان عن إسهامات العلوم الأخرى، لا يتيح إدراك الجوهر، والإجابة عن الهواجس الأخلاقية. إن تدريس تاريخ العلوم والثقافة والفلسفة والفنون- وهو تاريخ غير مثالي- همش تماما بل أقصي من التعليم الديني.
فبعيدا عن الممارسات الدينية، لا ننشر إلا القليل مما يدعو إليه الإسلام من احترام للإنسان، والعدالة الاجتماعية، ورفض العنصرية، وحماية البيئة، وصحبة الوالدين وتوقير كبار السن، إلخ.
إن هذا التعليم المجزأ والشكلي والسطحي ليس قادرا على جعل المسلمين جاهزين بما فيه الكفاية لمواجهة التحديات المعاصرة، التي نذكر منها بداية إنهاء الاستعمار الثقافي، لأنه بعيدا عن الاستعمار السياسي الذي تجووز اليوم في أغلب الدول، فالبرامح والمصطلحات والأولويات التربوية غالبا ما يتم صياغتها وإعدادها في الخارج.
تبقى في حوزتنا ورقة رابحة وهي رسوخنا وتشبثنا الثقافي النابع من وعينا الفردي والجماعي العميق الذي يتجلى في صلتنا بكل ما هو رباني، وبما تشربته قلوبنا من قيم روحية، والذي قد يكون مصدر التجديد والأمل في النهضة، كما حدث على مر التاريخ.